بسم الله الرحمن الرحيم
مجموعة البُشْرَيات
قِسْمُ التَّفْرِيغِ وَالنَّشْرِ
تفريغ خطبة
أسباب تأخر التمكين
للشيخ: أبي قتادة عمر بن محمود
من سلسلة دروس الشيخ أبي قتادة القديمة
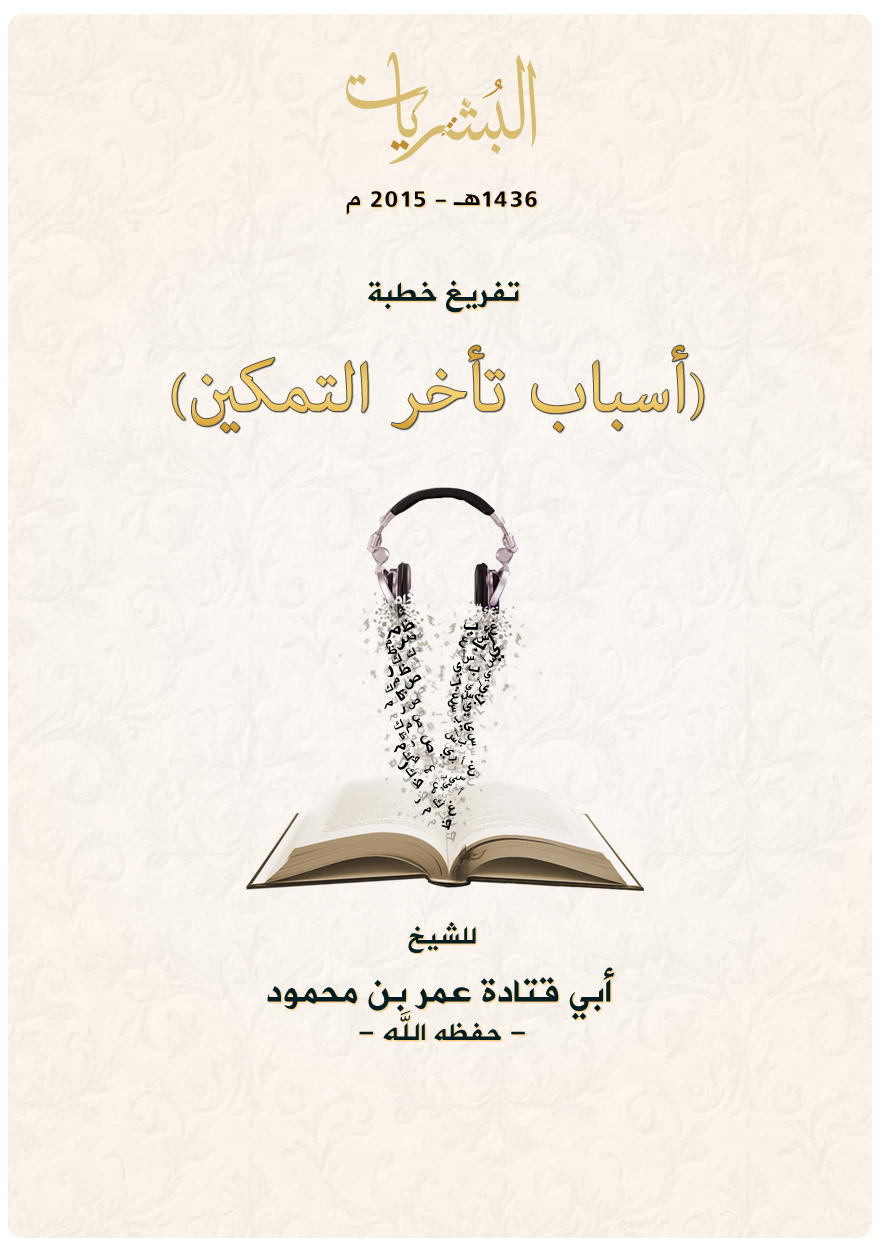

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له؛ وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله؛ بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين؛ وتركنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المحجة البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال؛ أما بعد:
من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا.
أيها الأحبة! إن الوصول إلى التمكين هو نعمةٌ من الله -سبحانه وتعالى-، والربط بين ما هو نعمة وبين ما هو نقمة بالنسبة إلى عمل الإنسان، ربطٌ يغلب عليه رحمة الله؛ أما أن التمكين نعمة، فانظر إلى قوله -سبحانه وتعالى-: {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ}، إذًا هو منة، {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ}.
ثانيًا: الربط بين ما هو نعمة وبين ما هو نقمة، في علاقته مع عمل الإنسان وحركته، تغلب عليه رحمة الله -سبحانه وتعالى؛ فإن ربنا في العذاب قال: {وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}، وقال: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ}، فإذا أذنب العبد وأصاب المعصية، كان عذاب الله -عز وجل- ونِقمته على عبده العاصي، أقل بكثير مما يستحق؛ فلو عذب الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ثم ربنا -سبحانه وتعالى- يعفو عن كثير.
وتمام العدل سيئةٌ بسيئة، ويعفو عن كثير؛ إذًا هي الرحمة منه -سبحانه وتعالى-، حين يعصي العبد فيسلب الرب -سبحانه وتعالى- منه النعمة، ويكون السلب تغلب عليه الرحمة، وحين ربنا -سبحانه وتعالى- يريد أن يجازي العبد، يريد أن يعطيه ويمن عليه، بحسنةٍ وعملٍ صالحٍ أصابه هذا العبد؛ فإنه يعطيه أكثر من مجال العدل، وأكثر مما يستوي فيه الميزان، ويكون الفضل الإلهي يغلب على هذا العطاء.
ولذلك قال –سبحانه-: {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً}، ثم قال: {وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ}، والاستضعاف ليس سببه قط، لا يكون سببه ولا تكون نتيجته هو التمكين والولاية، بل الاستضعاف يكون سبيله السحق والإبادة؛ فلما كان الرب -سبحانه وتعالى- يتعامل مع عبيده بالرحمة، ويتعامل بالعطاء الأغلب؛ فإنه يعطي على الحسنة عشر أمثالها، ويضاعف إلى سبعمائة ضعف.
وكذلك -سبحانه وتعالى- في قضية التمكين، المرء يكون مستضعفًا، والله -سبحانه وتعالى- يمن عليه ويعطيه، حتى إذا وقع الفضل الإلهي على هذا الإنسان، بالتمكين والرفعة، نسب الخير كله إلى الله؛ لأنه كان يعلم -وهو البصير- هذا الذي يستحق نعمة الله، هذا لا بد أن يكون بصيرًا بما تقع به الأحداث، وكيف تجري السنن؟
لا بد أن يكون بصيرًا، فإن نعمة الله لا تقع على الجاهل؛ وقد قال علماؤنا: (ما اتخذ الله وليًا جاهلًا)؛ فلا يكون الولي لرب العزة والجلال جاهلًا. والعالم: هو الذي يعلم الشرع، أحكام الدين، سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا الذي يسميه علمائنا بتوحيد الشرع؛ ويكون عالمًا كذلك بوقوع السنن وجريانها في الحياة؛ لماذا وقع هذا بارتباطه مع ذاك؟ وكيف يقع هذا الفعل؟ وكيف يتحقق؟
وهذا الذي يسميه علماؤنا بـ(توحيد القدر)؛ فالعالم: هو الذي يعلم توحيد الشرع، وهو الذي يعلم توحيد القدر، فالبصير أي العالم بهذين الأمرين: بتوحيد الشرع وتوحيد القدر، إذا وقعت عليه نعمة الله، بأن من عليه بالولاية وأن من عليه بالتمكين؛ علم أنه لم يكن يستحق هذا من جهة العدل، وإنما أعطاه الله إياه، من جهة المنة والفضل وغلبة الرحمة؛ هذا هو الأمر الذي تجري به سنة الله، في تعامله فيما يقع مع العباد.
وهناك فرقٌ أيها الأحبة، فرقٌ كبير بين أن لا يكون الرجل أو يكون المرء أو تكون الجماعة، تستحق من جهة قوتها أن تكون ممكنةً وليةً للناس؛ وبين أن تكون هذه الجماعة ويكون هذا الفرد عنده الاستعداد، بأن يكون ممكنًا ووليًا للناس. وهذه النقطة المهمة في بيانها، يعجز الكثير من الناس عن النظر إليها، أو الاهتمام بها، فيتم الخلط؛ عندما قال ربنا -سبحانه وتعالى: {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ}.
هؤلاء الذين لا قوة لهم ولا حول، ولا طاقة لهم بالشيطان وجنده، وليس عندهم من أدوات النُصرة والتمكين، ولا من أدوات الولاية على الناس؛ هل يعني ذلك أنه ليس عندهم الاستعداد أن يكونوا أهل تمكينٍ، فيقيموا حق الله والعدل في الناس؟ من هم الضعفاء، الذين يمن الله -عز وجل- عليهم؟ هل أولئك الجهلة؟ هل أولئك الأغبياء؟ هل أولئك العميان ببصائرهم؟ ثم بكل هذه التشوهات وبكل هذا الخلط وبكل هذا الضعف في الإدراك، يريدون أن يصيبهم قوله -سبحانه وتعالى-: {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ}!
تأتي إلى جماعةٍ من الجماعات لا تهتم بالعلم، الذي هو أساس الفضل الإلهي؛ فلا يقع فضلٌ قط من غير علم، لا في مسائل الدنيا ولا في مسائل الدين، لا يمكن أن يقع فضلٌ إلهي على أحدٍ من الناس إلا بعلم؛ فالجهل هو أساس الفساد، والعلم هو أساس الرقي والعبودية لرب العباد. فتأتي إلى جماعةٍ أو تجمعٍ، لا يهتم برفع مستوى العلم في أفراده، ويبلغ على هذه الجماعة الجهل، وربما يكون الجهال البسيط، أو يكون الجهل المركب؛ فتقول له وتحاوره أنتم جماعةٌ جاهلة، عليكم أن تتعلموا، فهو أساس تقدمكم إلى مقاصدكم، والتي هي إن أخلصتم النية، هي مقاصد الإسلام كذلك. قالوا لك: وإن يشأ يبارك على أوصال شلوٍ مُمَزعٍ، نحن ضعفاء الله يبارك فينا.
والفضل الإلهي إنما يقع على الضعفاء؛ ويظنوا بهذا، أنه بهذا الضعف يتم تحقيق المنة الإلهية والوعد الإلهي، ولو وقع هذا أيها الأحبة، لكان في ذلك مفسدتان عظيمتان، لو وقع الفضل الإلهي على جماعةٍ جاهلة، أو على فردٍ جاهل، أو على أمةٍ جاهلة؛ لوقع الفساد في سنة الله وفي كونه في قضيتان:
القضية الاولى: هو إفسادٌ لسنة الله التي تقوم على الحق والعدل؛ فسنة الله -سبحانه وتعالى- تجري، على أنه لا يعطي شيئًا من غير مقدمة؛ الله -سبحانه وتعالى- لا يعطي شيئًا من غير أن يبذل الإنسان وسعه، قد يكون هذا الوسع كافيًا لتحقيق المراد، والأغلب أن لا يكون كافيًا كما تكلمنا في باب الرحمة وميزان العدل، لا يكون كافيًا لتحقيق المراد.
ولكن حين يبذل الإنسان طاقته، وهي غير كافية، فيقع المراد؛ حينئذ يشترك الاستعداد لدى الإنسان لهذا الفضل وإرادته لتحقيقه؛ وهذه هي العبودية من عمل الإنسان بربه، ويتحقق الفضل الإلهي من فعل الرب فيه، وكلٌ من خلق الله؛ أي إرادة الإنسان، ونعمة الله للإنسان، فهذه هي سنة الله: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}.
لا بد من وجود إرادةٍ من قبل الإنسان، تحرك فيه وسعه وطاقته قدر ما كانت، من أجل تحقيق المراد؛ فقد تعجز هذه الطاقة من تحقيق المراد، فيأتي الفضل الإلهي ويجلبه إلى المقصد؛ فحينئذ تمت نعمة الله وتمت عبودية الإنسان، أما أن تقع المنن الإلهية، ويقع الفضل الإلهي على هذا الإنسان، من غير وجود إرادةٍ منه؛ حينئذٍ يقع الفضل من غير عبودية.
ومقصد الرب أن يبرز عظمة الألوهية، ومراد الرب أن يبين الفارق بين من يرتكس، في هواه وفي شهوته، وبين من ينشط من أجل تحقيق عبودية الله، فإذا وقع الفضل الإلهي من غير عبوديةٍ من الإنسان؛ اختل هذا الميزان، وكان فسادٌ في الأرض، وهذا يدركه العقلاء.
أما الفساد الثاني: وهو الأعظم كذلك، وهو أن يتم حصول الشر والفساد في الأرض باسم الدين، وهذا فسادٌ عظيم، أن يقع فسادٌ في الأرض باسم رب العزة والجلال.
فإذا مُنَّ على جماعةٍ بالتمكين، وهي لا تستحق هذا التمكين، من جهة العلم والإدراك، لا من جهة القدرة؛ فإن الله إذا مكن أعطى القدرة، ولا يمكن أن يكون تمكينٌ بغير قدرة. ولكن أتكلم على جهة العلم، إذا أعطى ربنا -سبحانه وتعالى-، منةً لأمةٍ من الأمم؛ فمكن لها في الأرض، وأعطاها الغلبة والفوز والسؤدد باسمه، ثم بعد ذلك ستمارس هذه الجماعة أعمالًا في الخلق، يبرزها هذا التمكين وهذه المنة؛ فماذا سيكون من هؤلاء الجهلة؟ ماذا سيقع منهم في أولئك الضعفاء، الذين غلبوا على رقابهم؟
لن يكون إلا الفساد، وهذا الفساد شره مضاعف؛ لأنه يكون واقعًا باسم الله، وواقعًا باسم الإسلام، ووقوع الشر باسم الإسلام أعظم ما يكون حاجبًا، عن أن يرى الناس دين الله على حقيقته؛ ولأضرب لكم مثالًا في واقعنا: مسألة زواج المتعة، ويا أيها الإخوة! إن الأمور حين تبقى في مجال الفكر والعقل، وفي مجال النظر والمعارضة، حين تكون كذلك يكون الخصم يسيرًا في الخلاف؛ فلو افترضنا أن رجلًا وآخر قد اختلفا في مسألةٍ من مسائل الفقه، من جهةٍ نظريةٍ علميةٍ عقليةٍ فقط، إنما عظمة فسادها تكون في الخلاف الذي بينهم، لكن يظهر الفساد على أشده، وتظهر الطامة، حين يتحقق هذا الخلاف من جهةٍ عملية.
إذا اختلف رجل وآخر في مسألة؛ لو افترضنا أن رجلًا يخالف آخر في جواز الصلاة بين الحنفي والشافعي؛ كمسألةٍ يسيرة، وهذه مسألةٌ وقعت في تاريخ أمتنا، وغلبت على أمتنا عدة قرون؛ لو قال رجلٌ: أنا لا أصلي وراء حنفي، وقال شافعي: لا يُصلى، وكان أساس هذه المسألة المذهبية (أأقلد؟ أم لا أقلد؟).
فلو تناظر رجلان في بيئةٍ فكرية، يكون الخصم يسيرًا؛ فمجال الخصومة إنما هو الحديث، لكن لو ذهبنا إلى التطبيق العملي لهذه المسألة، إلى واقعها، وأن تتقسم الأمة على أرض الواقع أحزابًا وفئات، وأوزاعًا وجماعات، كيف سيكون الواقع؟ سيكون مذهلًا، سيكون كبيرًا، وأنتم أيها الأحبة! تعجبون من بعض الوقائع في واقعنا؛ من تقاتل أحزابٍ وجماعاتٍ إسلامية بين بعضها البعض، لا يختلفون بالكلام والمناظرة، ولا في تأليف الكتب، ولا في مسائل ذهنيةٍ عقلية.
إنما قد وصل الخلاف إلى القتل، وإلى الضرب بالصواريخ، وإلى المعارك بالأسلحة؛ فتعجبون من هذا، وليس العجب منها، إنما العجب من التهوين، حين يكون الخلاف بين الناس؛ لنفترض في مسجدٍ من المساجد، أو في مصلى من المصليات، ذاك يرى أنه يجوز أن يلغي الآخر حتى بقوة السلاح، منشأ هذا هو ما كان يحصل في المسجد، وما كان يحصل في تجمعٍ كان الحوار كلامي فيه؛ لأنه حينئذٍ في تلك الحقبة، وفي ذلك الزمن، لم يكن في وسع أحدٍ إلا الكلمة، فكان التراشق بالكلمة، وكان التساب باللفظ؛ فحين قوي هذا وقوي هذا، صار يملك هذا سلاحًا وهذا سلاحًا، حينئذٍ سيكون (القتل، الحسم) والخلاف بمستوى قوة السلاح الذين بين أيديهم.
انظروا إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-، وتفكروا في هذا؛ في صف النبي -صلى الله عليه وسلم- للصلاة، يقول: (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم)؛ قد يقول قائل: وأي أثرٍ لما يحدث من خلاف في صف الصلاة، لعدم تسويته على خلاف القلوب؟ وإن قوله -صلى الله عليه وسلم- (فتختلف قلوبكم): يدل عن ما وراءه؛ إذا اختلفت القلوب، فإن اختلاف القلوب يؤدي إلى ما يؤدي؛ وإلى أسفل ما يؤدي أن يقتل الرجل أخاه، كيف منشؤه؟ (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم).
إذا كانت هذه المسألة العملية بدقتها، تؤدي إلى أعظم مما يتصور الإنسان في خياله، من ثمرات اختلاف القلوب؛ حينئذٍ تدرك أن ما يحدث من خلاف بين الناس، في مسائل العلم ليس بهينٍ، إذا ترجم إلى مسائل العمل.
مسألة المتعة، كنت أريد أن أضرب لكم هذا المثال؛ المتعة، سهلٌ جدًا أن تؤلف كتابًا فتخالف فيه الشيعي، أو أن يخالفك فيه الشيعي في هذه المسألة؛ وهذه المسألة قال بها بعض أهل السنة، وإن كان بعد ذلك قد انعقد إجماع أهل الأمة على تحريمها، ولم يبق على الشذوذ إلا الرافضة.
بصورةٍ خلافية، قد يأتي رجلٌ ويختلف معك في هذه المسألة؛ لنفترض أن رجلًا سنيًا اختلف معك في هذا، لكنك تختلف معه والحوار يدور بينكما في نطاقٍ ضيق، وهو نطاق الكلمة؛ لكن هذا الخلاف حين يأخذ بعدًا عمليًا، وهنا تكمن الخطورة؛ رجلٌ يريد -حاكمٌ- يريد أن يحل المتعة، للمجتمع الذي تمكن منه، وباسم الإسلام! ما هي صفته؟!
هناك دراسةٌ أنقلها لكم، لامرأة درست صورة المتعة، عمليًا لا نظريًا، واقعيًا لا فقهيًا، كيف تقع المتعة على أرض الواقع؟ المتعة: هو الجواز المؤقت، هو أن يجوز للرجل أن يعقد على المرأة عقدًا بمهر، أجرة لمدةٍ محدودة، غير مقدرةٍ طولًا ولا قصرًا؛ يعني يجوز له أن يعقد عليها لمدة نصف ساعة، يقول: تزوجتُكِ لمدة نصف ساعة على خمسين دينارًا! أو يعقد عليها عقد متعة مفتوح، يجوز له بعد ذلك أن يطلقها متى شاء! أو أن يعقد لمدة لحظة، بأن يحصل منها القبلة فقط! ويقول هذا الفقه!
قد يقول قائل: إنما هو خلافٌ فقهي، كان السلف يقولون به، أو كان بعض السلف يقوله. قلت: لا أناقشك في هذا، تعال لأريك واقع الخلاف؛ لو أنه وقع، وقد وقع. ثم من المتعة أي من فقه المتعة، أن لا يسأل الرجل من تمتع بها، ألها زوجٌ أو ليس لها زوج؟! أحائضٌ أم طاهر؟! أهي في عدةٍ أم لا؟! أحاملٌ أم لا؟ّ هكذا هو فقه المتعة.
ما هي صفته العملية؟! لو أن رجلًا أراد أن يقرأ واقعه ويتخيله، لن يزيد عما هو على أرض الواقع؛ ذهبت امرأة -هي علمانية، لكنها ابنة أحد آيات الشيعة الكبار، واسمه آية الله الحائري، هي حفيدته، تسمى شهلة الحاير- ودرست المتعة قبل أن تقنن فقهًا في إيران؛ فرأته يمارس على صيغةٍ فردية، باستراقٍ في حجر المساجد، وبين رواقات المشاهد الشيعية.
صورةٌ تمارس انتقاطًا فرديًا؛ لكنها حين تقنن، ويقول قائلهم مثلًا؛ مثل محمد باقر الصدر، يقول إنه: لا يمكن القضاء على دور الزنا، ومواخير الخنا، إلا بتطبيق المتعة! كيف نريد أن نطبق المتعة؟ كانت صورتها هي صورة الزنا، لكنه على باب الماخور، على باب دار العهر، مكتوبٌ: (بسم الله). الناس إذا مارسوا الزنا باسم الهوى تابوا، وإذا مارسوه باسم الإسلام كيف يتوبوا؟!
ومن هنا قال علماؤنا: (ليس لمبتدعٍ توبة)، وليس هذا على صفة الأمر؛ أي إنه لا تقبل توبة المبتدع، لكن هذا اللفظ، وإن كان على صفة الأمر فهو على جهة الخبر؛ بمعنى أن المبتدع لن يتوب، لماذا؟ لأن المبتدع إنما يفعل فعله باسم الله، ويفعل فعله باسم الدين، ويفعل فعله باسم الشريعة؛ ومن كان يعمل مثل ذلك، فلا يمكن أن يتوب.
كيف طبقت المتعة واقعيًا؟ سهلٌ جدًا، بدل أن يقوموا بالزنا، الذي هو المتعة، في أروقات المشاهد، وفي الحواري الضيقة، وبعيدًا عن أعين الناس؛ ما كان منهم إلا أن أنشؤوا فنادق فيها النساء، وتحت الفندق يوجد شيخٌ مهيب، صاحب لحيةٍ طويلة، وعمة على رأسه؛ وهو الذي يسمى بالقواد، لكنه شيخ! وآيه من آيات الدين! يجلس في أسفل الفندق في الاستقبال، يدخل عليه الباحث عن الزواج، يريد أن يتزوج، فيدخل؛ يكون من الشيخ (القواد) أن يخرج له ألبوم الصور، للنساء الماكثات في الفندق، المنتظرات الأزواج؛ فيخرج له الألبوم يفتحه أمامه!
وليس عيبًا أن يدخل الشيخ بلحيته، أو أن يدخل رجل متدين على زيه وهيئته؛ فيدخل يقول لذلك الشيخ، أو لآية الله (القواد) يقول له: أريد أن أتمتع. فيفتح له الألبوم، فيقول له: اختر أي امرأةٍ لتتمتع لتتزوج، لا لتزني، لتتزوج بها، فيقلب الرجل الصور، ويختار صورةً يرضاها نفسه؛ فما يكون من هذا المستقبل، إلا أن يستدعي المرأة من غرفتها، ويجلسهم أمامه، ويعقد بينهما، كم تحتاج مدة الزواج؟ يقول: ربما نصف ساعة تكفيني، أو ساعة تكفيني، أو هل تسمح لي أن آخذها إلى بيتي لمدة اسبوع؟ فأنا سأمكث في هذه البلدة أسبوعًا. فيتم العقد والزواج على هذا، ويمهرها بالمال، وبعد ذلك تذهب معه ويتم العقد!
هكذا أيها الإخوة! نعود إلى القضية، وهي أعظم مفسدةٍ إذا وقعت المنة الإلهية على أناسٍ جهلاء؛ وقلنا الجهل؛ إما أن يكون بسيطًا: وهو عدم العلم بالشيء، وإما أن يكون مركبًا: وهو العلم بنقيض الشيء. فهؤلاء جهلة، ظنوا الحرام حلالًا، وظنوا الزنا بصورته الواقعية العملية أنه شرعٌ ودين، وهم بهذا -كما يقولون- يقضون على الزنا؛ أرأيتم مفسدةً وقوع المنة الإلهية على قومٍ لا يستحقونها؟ كيف يكون أثرها على الإسلام؟ وكيف يكون أثرها على هداية الله للخلق؟
أليست الدولة الإسلامية ومقصد التمكين في الأرض: هو إدخال الناس في الدين، أي إن أعظم مقصدٍ تقوم به دولة الإسلام؛ هو هداية الناس إلى الإسلام، أن تحمل الدولة الدعوة هذا هو مقصدها؛ فإذا كانت هذه صفة التمكين وصفة الدولة، فكيف سيدخل الناس دين الله؟ الأمثلة التي تدل على أنه من رحمة الله أن لا تمكن الأمة، وهي في وضعها هذا كثيرًا؛ كيف يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأمانة، حين ترفع من جذر قلوب الرجال؟ قال: (وترفع الأمانة من جذر قلوب الرجال، حتى لا يبقى أمينًا، حتى يقول الناس: إن في قبيلة فلان رجلًا أمينًا).
إذا كان الحاكم لصًا وباسم الإسلام، وإذا كانت الرعية لصوص وكذبة وباسم الإسلام؛ فكيف سيكون الحال؟ واعذروني إذا قلت لكم، إذا أردتم أن تروا صورة الخلافة القادمة إذا وقعت علينا، إذا وقعت منة الله بتحقق الخلافة على رموزنا، على هذه الحركات، وعلى هذه التجمعات، وعلى هذه الأمارات؛ إذا أردتم أن تروا صورها في واقعها المستقبليّ، فانظروا إليها في واقعها الحاليّ وكبروها؛ أي كبروا هذه الصورة، وبدل أن يملك المخالف لك لسانًا، ارسم بيده سيفًا.
أي حين يكون الخلاف باللسان، سيكون الخلاف يوم ذاك بالسيف، والقتل والتدمير للمخالف؛ إذا أردتم أن تروا خلق خليفتنا القادم، إذا تحقق الفضل الإلهي في هذه الأيام؛ فانظر إلى صورة أميرنا في جماعتنا، مكبرًا في ذلك الوقت؛ لتروا أي صورةٍ مخزيةٍ مهولة حينئذٍ. وكلامي هذا انبه على نقطةٍ مهمة؛ فهو حديثٌ عن جانب القدر، وليس عن جانب الشرع؛ بمعنى إن هذا الذي نتكلم به، هو من أجل بيان نعمة الله علينا، بأننا نتخاصم ولا نملك إلا اليد، ونتشاجر فلا نملك إلا اللسان، هو حديثٌ عن نعمة الله علينا.
وإلا بفجورنا هذا، وبكذبنا هذا، وبأخلاقنا هذه، وبظلمنا بين أنفسنا هذا، على كل مستويات ما يسمى بالمسلمين؛ جماعات، تجمعات، مجتمعات، أفراد، أسر، هو تحديثٌ عن نعمة الله، بعدم تحقق التمكين؛ لعدم وجود قابلية التمكين، بالتقوى، بالقوة، بالأمانة، بالصدق، بالعدل، بالوفاء، بالاخلاص للناس قبل الاخلاص للنفس؛ هو تحديثٌ عن نعمة الله فيما فينا، وعدم اتهام حكمة الله بأنه أصابها في هذا الوقت فلم يعدم تمكيننا.
ليكن لليهود دولة، وليكن للنصارى دولة، وليكن للمجوس دولة؛ فهؤلاء لا يستندون إلى كلمة الله الحقة، ولكن أيكون للمسلمين على هذا الواقع دولة؟! وكل جماعة منهم على خلاف مستوياتهم تكذب وتفتري وتظلم، حتى أنها تظلم بعضها بعضًا. هو حديثٌ عن القدر. هل هو حديثٌ عن الشرع؟ الجواب: لا، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما: في أنه لا يجوز لأحدٍ أن يتخذ هذا الواقع الذي وصفناه حجةً؛ من أجل توقف سعيه لإقامة حكم الله في الأرض.
يجب على كل واحدٍ فينا أن يصلح نفسه، وأن يسعى جاهدًا لإقامة دولة الله في الأرض؛ فإذا وقعت، فإنها لن تقع إلا على من يستحقها، هلا كنت من جهة الشرع، هلا كنت داعيًا ولو بخُطوةٍ واحدة، إلى تقريب هذه الدعوة العدل، إلى تقريب نعمة الله ومنة الله. فكلامنا إذًا من أجل أن نراجع أنفسنا. أننا نحن بذواتنا وأشخاصنا، وعقولنا وقلوبنا، وحركاتنا وقفنا سدًا منيعًا قبل أعداء الله، من تحقق دولة الإسلام: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}.
فأنت العلة، أنت الشر، أنت الأفعى التي جلست فوق البئر، فلم تشرب منه وحرمت الآخرين من الشرب منه؛ سبب الفساد منك، أي منا نحن بأخلاقنا، وسلوكنا، وجماعاتنا؛ فعلى كل جماعةٍ: أن تتقِ الله في نفسها، وأن تكون عادلةً صادقة، وعلى كل متكلمٍ: أن يكون صادقًا، أن يكون أمينًا، أن يكون وفيًا لدينه، أن يراجع علمه، أن يقرأ، وأن يتعلم، وأن يرفع مستوى أفراده؛ لأن الدولة لا تقوم على جهل، القنابل تدِمر، القنابل تدمِر لكنها لا تبني.
ما معنى هذا الكلام؟ الجهاد –يا إخوتي- لتدمير الآخر، لكن الجهاد لا يصنع النفس؛ والدليل ما حدث في أفغانستان؛ كان الجهاد وما يزال، هو الطريق الوحيد لإزالة الطاغوت؛ أزلنا الطاغوت، جاهدنا فأزلناه، حينئذٍ ما الذي يبني؟ ما الذي يوجدنا نحن؟ ما الذي يوجد هذا؟ إنما يوجده العلم، ويوجده تحقق دين الله فينا؛ علمًا وإرادة، أي علمًا وعملًا، وبهذا فإن الأمة عندها القدرة؛ لو أرادت في الواقع هذا أن تدمر أي طاغوت، ولكني توصيفًا للواقع والأمانة، ليس عندها القدرة أن تبني دولة الإسلام، أن تزيل دولة الكفر نعم، أن تقيم دولة الإسلام؛ واقعنا يدل على خلاف ذلك.
فما المطلوب منها؟ أن نرحم على أمتنا، أن نرحم على أنفسنا، أن نهتم بعلومنا مراجعةً ومذاكرة، تصويبًا وصلاحًا، رفعًا لذوقنا في النظر إلى شرع الله، وإلى قدر الله، رفعًا لمستوى أفرادنا، مستوى الناس، مستوى الأمة؛ الأمة حين تكون جاهلة، تصلح لأن تكون مطية لكل أحد، وحين تكون عالمة، لا تصلح إلا أن تكون -إن جاز التعبير- مطيةً لدين الله -سبحانه وتعالى-. وعلينا أن نصلح ما بأنفسنا، وأن نراجعها، وهذا حسابٌ دنيوي، بيننا وبين الله؛ وأما الحساب الأخروي، فالأمر فيه أشد.
أيها الإخوة الأحبة! إن ما نعيشه من هذا الواقع التعيس، وما نعيشه من عذاب، وما نعيشه من بؤس، هو {وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}. ولو آخذنا الله -عز وجل- بما نكسب؛ لكان عذاب الله أشد، وكانت نقمة الله أعظم؛ فواقعنا -أيها الإخوة- يقل كثيرًا عما نستحقه من العذاب، ومن سلب القوة، ومن الدمار، ومن الخزي الذي نعيشه، ومن الذلة التي نحياها.
واقعنا -أيها الإخوة- هو فيه رحمة الله، ولولا رحمة الله -سبحانه وتعالى-، بأن يؤلف بين القلوب كثيرًا؛ وإلا فأعمالك، وكذبك، ودجلك، وافتراؤك، وظلمك، وجهلك، يقلب المقابل لك وحشًا، لا يرعوي فيك؛ ووالله لولا بقية دينٍ يضعها الله -رب العزة- في قلوب الناس؛ على الصبر على المخالف، وعلى الصبر على ظلم الجائر الظالم؛ لتحول شباب الإسلام فيما بينهم إلى وحوشٍ، وإلى كلابٍ مسعورة، لتحولت مساجد المسلمين ومصلياتهم، إلى أوكارٍ لكلابٍ مسعورة؛ لو تعامل كل واحد بما يعمل الاخر.
ولكن رحمة الله، بأن يضع في القلب اللين، وأن يضع فيه الصبر، وأن يضع فيه رجاء اليوم الآخر؛ أن يصبر، وأن يمرر، وأن يرجو الأجر من الله، ويتذكر قوله -سبحانه وتعالى-: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}، أن يتذكر مثل هذا، لولا هذه البقية الباقية من دينٍ في قلوب البعض، فوالله ما صار أهل الإسلام إلا رزيةً على بعضهم البعض، وإلا وحوشًا على بعضهم البعض، -وأعتذر- إلا كلابًا مسعورةً على بعضهم البعض.
فاتق الله في نفسك، واتق الله في أمة الإسلام، واتق الله في وعد الله القادم، إلى أمة محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-. فلا يعني الضعف الذي أعطى الله -عز وجل- به الوعد، أن لا يكون في الآخر القابلية لهذا الوعد؛ الجهل لا يصلح لوعد الله، الحقد لا يصلح لوعد الله، ولا يصلح للرئاسة ولا للقيادة؛ وهذا لم يدركه فقط أهل الإسلام، بل أدركته الجاهلية قديمًا قبل الإسلام.
قيل للأحنف بن قيس: بم وليت على قومك؟ بم سدت قومك؟ قال: (إنما يسود القوم الذكي المتغابي)، ما الذي يعنيه؟ الذكي المتغابي: هذا الذي لا يمكن أن يكون في قلبه الحقد؛ لأن من كان في قلبه الحقد، لا يمكن إلا أن يراقب كل نظرة؛ فيحاسب صاحبه عليها، وأن يراقب ويتجسس على كل كلمة؛ فيدخل في بواطنها، ويحمِلها رهقًا من المعاني؛ من أجل أن يقتص من صاحبها.
أما الذكي الذي يعلم الأمور ويتغابى؛ فهو سمح الصدر، لين القلب. فمنة الله لا تأتي على الجاهل، كما قالوا: (ما اتخذ الله وليًا جاهلًا). منة الله -سبحانه وتعالى- لا تأتي على الكذب، فلا يمكن أن يكون وليًا لله كاذبًا؛ حيث نفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل الكاذب صفة الإيمان. لا يمكن أن يكون التمكين، وأن تأتي منة الله -سبحانه وتعالى- على الظالم، كما قال -سبحانه وتعالى-، عندما طلب إبراهيم منه أن يبارك في نسله، فقال -سبحانه وتعالى-: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، لا ينال عهد الله -عز وجل- من ظلم.
وبه أخذ بعض العلماء، على عدم جواز تولية الظالم، وهذا أمرٌ شرعي وأمرٌ قدري؛ فالظلم لا يجتمع مع الإمامة، الظلم والحقد والكذب والجهل، صفات تحجز المرء من أن يصل إلى نعمة الله، بأن يكون إمامًا. إنما تكون الإمامة بالصدق، وتكون الإمامة مع العلم، وتكون الإمامة مع الصبر على المكاره، وتكون الإمامة مع اليقين؛ كما قال ابن تيمية: (بالصبر واليقين تنال الإمامة).
أيها الإخوة الأحبة! وأكرر وأقول، ليس هذا الكلام جلدًا لذواتنا، من أجل أن نعطل السعي، وأن نعيب من يسعى لتحقيق وعد الله، إنما هو مراجعةٌ لأنفسنا؛ لنسلك الطريق الصحيح، في كيفية تحقيق الوعد الإلهي، وإلا لن يقع.
ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يصلح قلوبنا، وأن يوفقنا إلى ما فيه العلم والخير والطاعة.
اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وأصلحنا.
اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء؛ نعوذ بك من فتنة القول و العمل.
اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، وارفع راية الجهاد، وأقم لنا دولة الإسلام؛ التي يعَز بها أهل طاعتك، ويذَل بها أهل معصيتك، وأقم الصلاة.

