بسم الله الرحمن الرحيم
مجموعة البُشْرَيات
قِسْمُ التَّفْرِيغِ وَالنَّشْرِ
تفريغ خطبة
سنة المدافعة
للشيخ: أبي قتادة عمر بن محمود
من سلسلة دروس الشيخ أبي قتادة القديمة
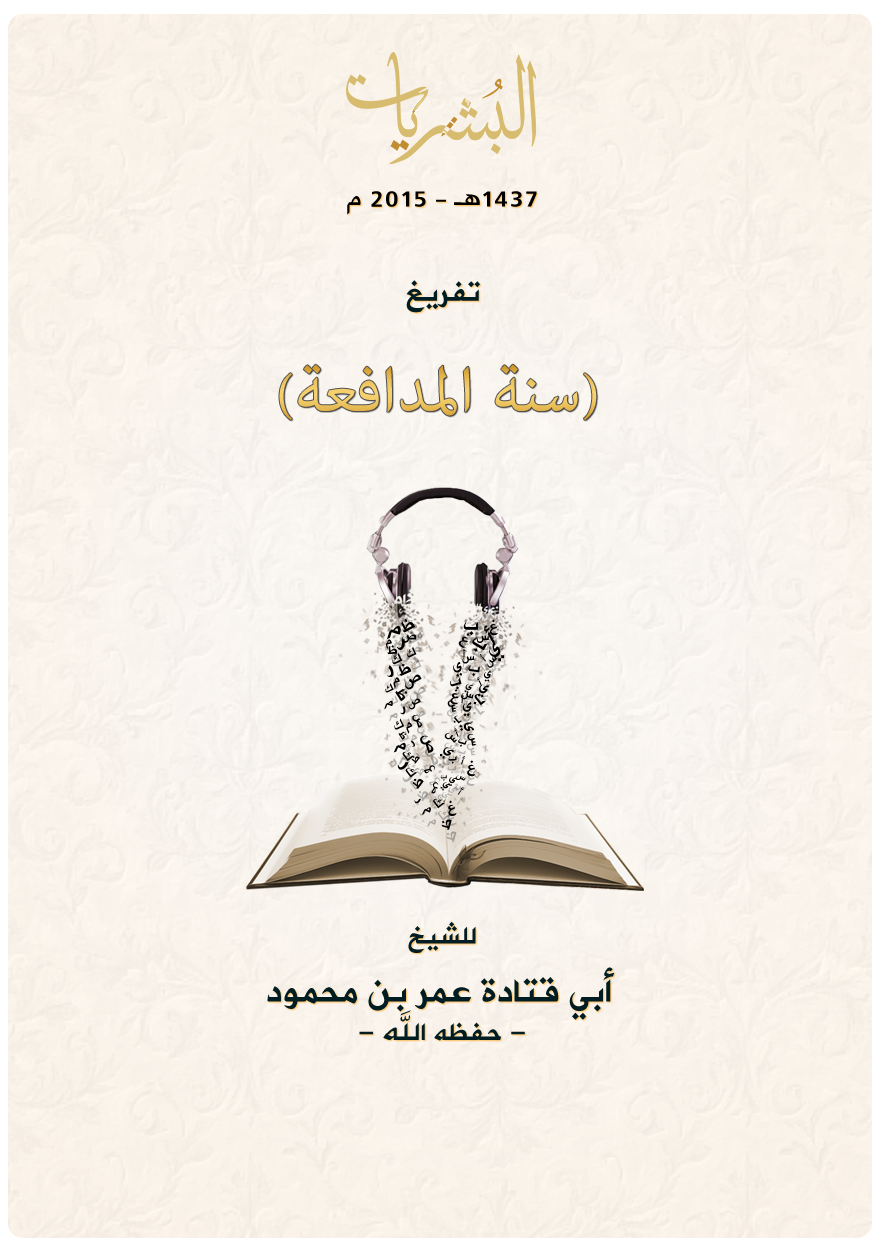

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله؛ بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين؛ وتركنا رسول الله ﷺ على المحجة البيضاء، والطريق الواضح، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال، أما بعد:
من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله؛ فقد ضل ضلالًا بعيدًا.
أيها الإخوة! كان من قدر الله -عز وجل- الحكيم، أن الله -سبحانه وتعالى- جعل في البشر مسيئًا ومطيعًا، جعل فيهم وليًا له، وجعل فيهم عدوًا له، وهذا من تمام حكمته، فإن الملائكة لما عرض الله -عز وجل- عليهم أمْر خلْق آدم: {قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}؛ وقد وقع في الخلق ما قالت الملائكة؛ من وجود أقوامٍ لا يشكرون الله، ويعصونه، ويسفكون الدماء.
ولكن قوله -سبحانه وتعالى-: {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}، إنما هو لوجود الصراع؛ ما بين المؤمنين وما بين الكافرين، ما بين الذين يسفكون الدماء بمعصية، وما بين الذين يسفكون الدماء بطاعة، ما بين الذين يريقون الدماء؛ من أجل شهواتهم، وتبعًا لأوامر شياطينهم، وما بين الذين يسفكون الدماء؛ تبعًا واقتداءً بأمر الله -سبحانه وتعالى-، وابتغاء مرضاته؛ فوجود الثلة المؤمنة، هي مقصد خلق الله -سبحانه وتعالى-، وهي ثلةٌ قليلة، ليست بالثلة كثيرة على مدار التاريخ.
لو أخذنا سيرة الأنبياء جميعًا، لوجدنا أنهم الأقل وأنهم الأضعف! وإن كثيرًا من أخبار القرآن الكريم، عن أقوامٍ امتثلوا أمر الله –سبحانه وتعالى-، لم تكن نهاية أمرهم العزة، ولم تكن نهاية أمرهم السؤدد والنصر! بل كان نهاية أمرهم العذاب والحرق، والسجن والطرد، والذبح والإفناء، هكذا كانت نهاية أمر الكثير، ممن أطاعوا الله -سبحانه وتعالى-.
ولذلك التاريخ الإنساني، منذ آدم -عليه السلام- إلى يومنا هذا؛ إنما شعاره سفكُ الدماء، شعاره الذبح؛ فإنه ما كاد آدم النبي الرسول ينزل إلى الأرض، حتى قتل أحد أبنائه الابن الآخر! هكذا افتُتحت الحياة، وهكذا جرَت على هذه السنن، شعارها الدفع؛ كما قال الله -سبحانه وتعالى-: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً}؛ {لَوْلا دَفْعُ اللَّهِ}: هذه المدافعة القليلة، ربما لا تصنع نصرةً كونيةً كاملة.
الخيال الإسلامي المعطَّل هذه الأيام؛ يسمع خيالاتٍ عجيبة لمهمة الجهاد، ولمهمة الذبح، ولمهمة القتال، فإن لم تتحقق هذه المهمة، المتخيَّلة في الذهن الكليل؛ ذهب يرمي هذا الجهاد، وهذا القتال، ذهب يرميه بأشد أنواع التهم، ويقذفه بأشد أنواع الباطل.
الخيال المسلم في هذا العصر، خيالٌ لا أريد أن أستطرد في بيان أصله، وأقول لكم: أن الكليات التي أحدثها عدو الله أرسطو، في نظرته للأمور؛ هي التي أفسدت العقل المسلم، أفسدت العلماء قديمًا، ثم سرى هذا الإفساد إلى العوام، حتى سرى في الشباب، فهو -هذا الشاب، وهذا القائد، وهذا المنظر- عندما ينظر إلى لأمور، ينظر إليها من نظرةٍ كليةٍ عامة! لا ينظر إليها، من نظرة ارتباطها بالله -سبحانه وتعالى-.
لا يسمي مسلم في هذه الأيام، معركةً من المعارك، ولا يطلق عليها لفظ العظمة -أنها معركةٌ عظيمة-؛ حتى تكون هذه المعركة كونية، شاملة للوجود بأجمعه.
ولا يُسمِي المرء في هذا الزمن، دولة من الدول أنها دولةٌ إسلامية حتى تُحكم؛ دولةٌ قد قُطعت، وسميت بعرف أهل الجهالة من المعاصرين بأنها دولة! فهل تسمى دولة في أذهان المسلمين؟ حتى يغلب حكم الإسلام الدولة بشمولها وعمومها؛ مع أن دولة النبي ﷺ، التي أقامها وسميت بدولة الإسلام، إنما هي المدينة؛ والمدينة في عرف فارس والروم، وفي قواعدهم وأحكامهم ودساتيرهم وأعرافهم؛ إنما هي في جزيرةٍ من الصحراء، كان الفارسي والرومي يخجل ويتأنى، من أن يرسل لها حاكمًا.
المدينة هي جزءٌ من الجزيرة العربية، هذه الجزيرة كانت الدول المتصارعة من فارس والروم؛ كانت هذه المدينة لا تُعد شيئا، بل لا تُعد الجزيرة العربية شيئًا!
هي مدينةٌ صغيرة، ربما لا يصل محيطها مائة كيلو متر مربع، في داخل جزيرة كبيرة؛ كانت هذه الجزيرة لا يُستحق لها النظر! ولا تستحق الاعتبار من قِبل كسرويٍ أو رومي؛ ولذلك لم تكن محكومة هذه الجزيرة، من قِبل رجلٍ لا رومي ولا فارسي؛ بل كان العربي في هذه الجزيرة، يعد من أشرف المقامات وأعظم المراتب، هو أن يوفق للوقوف أمام النعمان.
والنعمان إنما هو: وليٌ -أي عبدٌ- من عبيد كسرى!
النعمان حاكم المناذرة، كان وليٌ عبدٌ لكسرى؛ فالعربي في الجزيرة العربية، كان يفتخر أنه دخل قصر النعمان، ووقف على بابه، وسمع كلامه، وأكل من طعامه!
انظروا! هذه الدولة العظيمة! من مدينةٍ صغيرة، في جزيرةٍ -حسب قواعد السياسة في ذلك الزمان- حقيرة، وهي تسمى عندنا الآن...، لو ذهبتَ إلى عقلٍ المسلم، وقلت له: المدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم-؛ لظن أن المدينة إنما هي من المدن الكبرى العظيمة.
عندما غزت قريش المدينة، استطاع الصحابة في أيامٍ قلائل أن يحفروا حولها خندقًا! فما هي هذه المدينة؟ أين عظمتها؟ أين اتساعها؟ أين امتدادها؟ ولكن هي محط نظر الله -سبحانه وتعالى-.
الآن في هذا الزمان، المسلم يقال له: بوجود عملٍ من أعمال الإسلام؛ فإنه لا ينظر إليه، إلا باعتبار ما استقر في ذهنه من عظمة الكفار! ووصل الأمر إلى قضيةٍ خبيثة؛ وهي قضية النظر إلى شروق الإسلام من الغرب، هكذا يقولون الآن.
الآن مشايخ هذا الزمان، وقادة الحركات في هذا الزمان؛ تفسيراتهم وتعليلاتهم بالاهتمام، في بناء أعمالٍ إسلامية في الغرب، ودعوة المسلمين إلى الاهتمام بالدعاة، وإقامة المراكز، وتكوين المنتديات في الغرب، مع أنها مكلفة؛ لأن المركز الواحد من المراكز، الذي يقام هنا في أوروبا، يعدل مائة مركز من المراكز، التي تقام في أفريقيا وآسيا، وفي بلدٍ من بلاد المسلمين.
ولكن لماذا هذا الاهتمام، بإقامة هذه المراكز في الغرب؟ لماذا هذا الاهتمام بهذه الصورة؟ لأنهم يعتقدون، أن الشمس ستشرق مرةً أخرى من هنا، ولذلك تنظر إليهم! حتى أنهم ليعظمون المسلم الجاهل، إن جاء من بلاد الغرب! ويحتقرون المسلم العالم، إن جاء من بلاد المسلمين!
ولعل الكثير منكم، ممن ذهبوا إلى الحج والعمرة، سعى بكل جهده، أن يخفي جنسيته وبلدته، وأن يظهر جوازه الأجنبي؛ حتى يُحترم! مع أنه مسلمٌ! وإنما جاء للحج أو جاء للعمرة، أو جاء لبلدٍ من بلاد المسلمين، فإنه يُعظم لكونه أجنبيًا! يُقدس فكونه جاء من البلاد العظيمة!
ثم صاروا يقولون -وهذا قول بعضهم-؛ أن معنى حديث رسول الله ﷺ، بشروق الشمس وخروجها من المغرب، صار بعضهم يؤول هذا الحديث، تأويلًا باطنيًا خبيثًا؛ فيقول أن معناه: أن شمس الإسلام ستشرق من المغرب، فيأتي علينا أهل الغرب -مسلمون-؛ وبنوا على هذا بأن هذا البلاد، لا يمكن أن تفتح بالسيف والسنان، ولا يمكن أن تفتح بالجهاد والقتال؛ فبالتالي أن طريق فتحها هو الدعوة السلمية!
رتبوا على هذا قولًا آخر، انظروا!: إلى أن هذه البلاد، لا تسمى دار حرب! وإنما تسمى دار دعوةٍ وأمان! هكذا هي صورة الهزيمة، هي صورة النظر إلى واقع المسلمين؛ من نظرٍ كُلي، باحتقار أعمال الإسلام، صارت أعمال الإسلام مُحتقَرة لا قيمة لها؛ بالرغم أن هذه المدافعة، هذه المدافعة ولو كانت قليلة، هي التي تحفظ للإسلام وجوده، وهي التي تحفظ للعباد ذكرهم، وطاعتهم لله -سبحانه وتعالى-.
كم من خطبةٍ قامت يا قوم؟ وكم من شيخٍ قد تكلم، وسب السلام المزعوم شرقًا وغربًا، وملأ الدنيا خطبًا رنانة؛ من أجل سب السلام؟ ولكن لم يصنع هذا شيءٌ، مقابل عمليةٍ واحدة، هي ضمن سنة الله -عز وجل- في المدافعة: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ}؛ بسبب هذه السنة -سنة المدافعة-، يُحفظ للإسلام وجوده وإن كان قليلًا.
الدول بعضها متقدم وبعضها متأخر؛ ولكن كلها سائرة في نفس الطريق، في إزالة الإسلام، كلها سائرة في تفجير الأمة، وفي تقبيحها وتحقيرها وتكفيرها وزندقتها؛ كل الدول سائرة! لا فرق بين دولةٍ متخلفة ولا دولةٍ متقدمة؛ ولكن لعوامل زمنية فقط، ترى أن هذه الدولة، قد قطعت شوطًا بعيدًا بعيدًا؛ في إزالة الإسلام، وتجفيف وجوده في الأرض.
كما هو حال وشأن عدو الله -سبحانه وتعالى-، شأن الكافر اللعين حاكم تونس؛ فإن الإسلام في تونس، قد بلغ من درجة العداء له، ومن درجة إضعافه إلى مرتبةٍ عظيمة؛ حتى يتعزز أن تجد رجلًا، في داخل هذه البلدة، من لا يسب الله، ولا يسب رسوله ﷺ!
ناس قلّما ولو سرت في البلد في المدينة، ولو سرت أيامًا، قلما أن تجد امرأةً تغطي شعرها؛ ولذلك أعداء الله –سبحانه وتعالى- من الغربيين، يجعلون تونس النموذج لتدمير الإسلام، يجعلونها نموذج للقضاء على الإسلام؛ ويسمونه بلغتهم (القضاء على الإرهاب أو التطرف)!
ولكنهم قصدوا من ذلك؛ إزالة الإسلام من الجذور، إزالة الإسلام من القلوب، بين هذه الدول المتقدمة جدًا؛ في صراعها وفي حنكتها الشيطانية، في إزالة الإسلام من البلدة، وبين دولةٍ أخرى، لنقل الجزيرة؛ فإنها دولة لم تدخل العلمانية بعد، متجذرة في حياة الناس.
الدولة لا تفترق أبدًا، بين هذه الدولة الكافرة في الجزيرة، وبين الدولة الكافرة في تونس؛ ولكن هي مراحل، يسلكها هؤلاء الكفرة، للوصول إلى الحالة النهائية؛ وهي: {لاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ}.
إزالة الإسلام من الوجود؛ هذه هي مهمة الحكومات؛ ولكنها هذه دولةٌ متقدمة، متقدمة في الشر لإزالة الإسلام، وبين دولةٍ أخرى متأخرة، ولكنها ساعية بكل قوى لإزالة الإسلام، ولتدميره، وللوصول إلى الحالة المثلى، التي يسعى إليها الكفر وأهله؛ ولذلك صارت هذه الدولة، دولة مستشارة من قِبل الكفر؛ لتعلمهم كيفية القضاء على الإسلام! وكيفية إزالة الإسلام من الجذور!
لو بحثنا بحثًا دقيقًا؛ لوجدنا أن بعض الجماعات المهترئة البدعية، هي التي ساعدت هذه الدول اللعينة، على تمرير الكفر في البلاد؛ كيف هذا؟ لا يمكن للحاكم أن يلغي القلوب، لا يمكن للحاكم بكل سلطانه، أن يدخل إلى القلوب، فيزيل الإسلام منها. إزالة الإسلام من القلوب، يحتاج إلى فتوى، يحتاج إلى قناعة؛ تصنع عن طريق الفتوى، وعن طريق الشيخ.
ولذلك تأتي بعض الحركات، فتقطع هذا الحاجز، تقطع هذا الحاجز، بين المعصية وبين هذا الإنسان؛ فالمسلم بفطرته، لا يمكن أن يشرب الخمر، وإن شربها شربها وهو يعتقد معصيتها؛ ولكن مر على تاريخ الإسلام، كثيرٌ من الأمم من شربت الخمر، فغيرت أسمائها؛ كان أهل العراق يشربون النبيذ، ويترخصون فيه؛ وذلك بسب فتوى أهل العراق، بجواز النبيذ من غير العنب، ما لم يسكر.
فكان كثيرٌ منهم يشرب النبيذ، وربما يقع في المحظور، ويقع فيه ولا بد؛ ما الذي صنع هذه الحالة؟ إنما هي الفتوى، إنما هي الفتوى؛ وقال -صلى الله عليه وسلم-: (يأتي زمانٌ على أمتي، يشربون الخمر؛ يسمونها بغير اسمها)؛ لأنها كما قلت كثيرًا، تزيل الحاجز النفسي بين الإنسان وبين المعصية، لا بد من الشيخ؛ فالحركة أو الجماعة، تأتي فتتبنى أعمالًا، تقولها من قبل الدين؛ فتسهل للدولة معصيتها.
في مدينة الخليل في فلسطين، عجز الفسقة أن يفتحوا دار السينما، عجزوا، وكلما أراد واحدٌ أن يفتح سينما؛ قام الناس انتقامًا، بفطرتهم الإسلامية، وبأعرافهم ببُغض هذه الأمور، التي يسمعون عنها؛ فمنعوا بكل قوة أن تفتح، دار السينما في مدينة الخليل.
جاء حزب التحرير، وقال للناس: يجوز لكم أن تنظروا إلى الصور العارية، يجوز النظر إلى الصورة العارية! لأن المنهي عنه، هو النظر إلى حقيقة المرأة، وأما الصورة فليست هي المحرمة؛ وإذا قيل لكم: بأن المانع إلى التحريم، إلى النظر إلى المرأة العارية هو الشهوة، وهذا متحققٌ في الصورة؛ فقولوا: هذا أمرٌ ظني -كما يقولون-، هذا أمر ظني ولا يعلق به حكم.
بسبب هذه الفتوى؛ انتشرت أفلام الجنس في داخل البيوت. بسبب هذه الفتوى؛ صار الرجل لا يتورع، أن يحضر فلمًا جنسيًا عاهرًا وينظر إليه؛ فإن قيل، قال لك: هذا جائر! وهذه الفتاوى تجد صدًى نفسيًا، وتجد قبولًا في الهوى، في نفوس الناس. هكذا كثيرٌ من الحركات، مهدت السبيل، الاختلاط بين الرجال والنساء.
لا بد من الفتوى، لا بد من الفتوى؛ من قِبل العالم، من قِبل المفتي، من قِبل الشيخ؛ لتنقطع من نفوس الناس، تلك النوازع الخيرة، في منعهم من الإقبال على المعصية؛ نعود إلى ما قلنا عليه، وهذا الفارق بين دولةٍ ودولة، قد يكون وبل هو من أحد أسبابه تلك الممهدات؛ التي تصنعها فتوى جماعةٍ ما، أو حركةٍ ما، في أمةٍ من الأمم.
القضية العظيمة يا قوم! هو قانون المدافعة، القضية العظمى؛ هو ولو لم يبقَ إلا مجاهدٌ واحدٌ على ظهر الأرض، يطبق حكم الله؛ فإنه هو سبب بقاء الإسلام في الأرض. الدولة المصرية؛ عندما كانت مشغولة بالمجاهدين، وبالمتطرفين، وبالمقاتلين، كانت تغض الطرف عن جماعات الدعوة، وتغض الطرف عن جماعات البلاغ، وتغض الطرف عن جماعات العمل السياسي؛ انشغالًا بهم.
فلما ضعف أهل الجهاد، والدولة استطاعت حقيقةً بأن تضعف شوكتهم، وأن تقضي على الكثير من قواتهم؛ لمن فرغت يا قوم؟ لمن فرغت؟ فرغت لجماعات البلاغ والعمل السياسي، فرغت للإخوان المسلمين. هكذا هي سنة الله؛ المدافعة، وجود القتل، وجود الشعار لدى المسلم؛ بأنه لا بد أن يموت في سبيل الله، هي التي تصنع الخير في البلدة، هي التي تمنع الدولة من المجاهرة بمعصيتها.
لأنها إن جاهرت، علمت أنها لا بد أن تلاقي من المسلمين؛ العنت، والعذاب، والجهاد، والقتل، والتقتيل. ما الذي يمنع الدولة، الآن في الجزائر، من أن تلاحق المصلين؟ وأن تهدم المساجد كلها؟ وأن تعيد الأمر إلى ما كان عليه؛ من تكفير الناس، وإزالة الإسلام منهم؟ إنما هو وجود المقاتل، فإذا فرغت منه؛ عادت إلى بقية الناس، حتى دخلت على البيوت، وحاكمت الناس على فطرهم، وقلوبهم، ونزعات نفوسهم.
ولكنه حين يوجد المقاتل، حين يوجد المجاهد؛ فإن الدولة من أجل أن تعطي لنفسها الشرعية، وأنها ليست ضد الإسلام، فإنها تلقي، فإنها تترك هؤلاء؛ لعدم وجود الخوف منهم مؤقتًا، فتفرغ للمقاتل والمجاهد؛ هذه هي سنة المدافعة، التي عجز أهل الإسلام عن فهمها، ولم يُمتها إلا وجود الفطرة.
ما الذي منع موت محبة الجهاد من القلوب؟ ما الذي منع موت محبة القتال من نفوس الناس؟ أترون أن المانع هو فتوى المشايخ؟ أترون أن المانع هو تربيةٌ بيتية؟ يربى الابن في بيت أبيه، على محبة القتال والجهاد؟ هل هذا موجودٌ في بلادنا؟ أترونها البيئة التي تصنع محبة القتال والجهاد؟ ما هو المانع، من زوال محبة القتال، والجهاد من نفوس الناس؟ إنما هي الفطرة فقط، التي يستثمرها أهل الجهاد فقط؛ إنما هي الفطرة تستثمر من قبل المجاهدين، فتُنمى لتعميق أصولها وقواعدها، وتستثمر من أجل إحياء دين الله -سبحانه وتعالى-؛ هذا العمل الجهادي، الذي يكون في نظر...، ومن أكثر الناس احتقارًا لمثل هذه الأعمال الجهادية، هم جماعات الضلال؛ ممن انتسب إلى الإسلام.
وإلا، فالكفار يعرفون قيمة هذه الأعمال، وينظرون إليها نظرةً صحيحة، ويبذلون من أجلها الملايين، ويبذلون من أجلها الأوقات، والرجال، والأموال، والجهود؛ من أجل تحطيمها، ومن أجل الاعتناء بها. كم من الملايين تنفق الآن؛ من أجل إيقاف مد ما يسمى بالإرهاب؟ كم من الملايين؟ الكثيرة، الكثيرة.
لأنهم يعلمون أن هذه الجدوى، أن هذه الجمرة هي مكمن الخطر؛ هي التي تحفظ للإسلام وجوده، فإذا قضي عليها، ما الذي يمنع بعد ذلك؟ ما الذي يمنع من زوال الإسلام؟ ما الذي يمنع من ملاحقة الناس، وذبحهم؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ لا شيء؛ أهي تقوى الحكام؟ أهذا الكلام الذي يغضب القلب، ويثير الغضب؟
عندما يقبض على شابٍ مسلم؟ أو عندما تأتي الدولة، فتلاحق رجلًا؛ فيجعل يصيح في الصحافة والإعلام: (أنا لست مذنبًا، أنا لست إرهابيًا، أنا لا أؤمن بهذه الأفكار؛ إنما عملنا هو فقط الدعوة إلى الله!)؛ سبحان الله! هذا التبرؤ من الأعمال الجهادية؛ أيتبرأ الكفار منه؟
أمريكا دمرت مدينة، وما زال أثر هذه القنبلة يسري، في الأجنة في بطون الأمهات، جيلًا بعد جيل؛ دمرت مدينة في اليابان، بل دمرت مدينتين إلى يومنا هذا؛ أتراها قد اعتذرت؟ فقالت للناس: (أنا أعتذر)؟ بل هل يعتذر هؤلاء اليهود الآن، من قتل المدنيين؟ عندما سئل، من رمى القنبلة على مدينة هيروشيما، وهذا في العام الفائت فقط، وقد سئل: (هل تشعر بالندم، أنك قتلت المدنيين؟ رميت قنبلة على مدينة مدنيين؟).
وقتل المدنيين في هذه المعركة، هو الذي حسم المعركة؛ الجيش هو الجيش، والمقاتلون في ثغورهم، ولكن ما الذي حسم المعركة؟ ضرب المدنيين؛ فظن القادة اليابانيون، أن عند أمريكا الكثير من هذه القنابل؛ فخافوا على شعبهم فاستسلموا. عندما سئل هذا الطيار، الذي رمى هذه القنبلة على شعب فقتله: (هل تشعر بالندم؟ هل تحرك فيك ضميرك؟).
قال: (لا، نحن نحارب اليابان، نحارب بلدة؛ بمقاتليها، بحكامها، بمحكوميها، بصغارها، بكبارها، فكلهم محاربون)؛ هذه الكلمة، لماذا يخجل أهل الإسلام منها؟ لماذا يخجل أهل الإسلام؟ لماذا يُرهب المسلم من العمل الجهادي، مخافة أن يقتل مدنيًا؟ كان من حجج المشايخ، الذين فتنوا عن رؤية الحق، ومتابعة الباطل؛ أنهم قالوا: (لا جهاد حتى تتميز الصفوف، لا جهاد حتى تتميز الصفوف).
ما هي طريقة التميز؟ كيف يتميز أهل الإسلام، في بلدةٍ كالجزيرة العربية، أو مثل مصر، أو في بلاد الشام؟ كيف يتميز أهل الإسلام، عن أهل الكفر؟ كيف يتميزوا؟ إذًا لا جهاد! ما هي النتيجة إن ذبح الجهاد؟ ما هي النتيجة إن قتل الجهاد؟ إنما هو قتل الإسلام؛ إن توقف الجهاد، وتوقفت عجلته، يقتل الإسلام؛ الجهاد هو الإسلام.
ومن لا يعرف هذا، في هذا الزمان، من لا يعرف هذه القضية؛ أن وجود الإسلام مرتبطٌ بوجود المقاتل، إن وجود الإسلام مرتبطٌ بوجود الإسلام، فلينظر إلى الدول التي فرغت من المقاتلين؛ مثل سوريا: ينظر إليها، وينظر إلى أهلها؛ عندما فرغت من المقاتلين، كيف صار شأن حكامها مع محكوميها؟
وكذلك فلينظر إلى تونس، ينظر إلى هذه النماذج؛ ليعلم أن الدعوة إلى إيقاف الجهاد، هو إيقاف الإسلام؛ والتمايز لا يمكن أن يقع، إلا بعد أن يفرغ أحد الفريقين من الآخر؛ إما أن يفرغ أهل الإسلام من أهل الكفر، فلا يبقى في البلدة كافر، وإما أن يفرغ أهل الكفر من أهل الإسلام، فلا يبقى فيها إلا كافرٌ، معلنٌ لكفره، أو مؤمنٌ كاتمٌ لإيمانه؛ يخاف أن يظهر كلمة الله -سبحانه وتعالى-.
إذًا هذه القضايا، وهو قانون المدافعة؛ هو الذي يحفظ للإسلام وجوده، قل أو كثر، علينا أن لا نتابع أولئك المشايخ؛ الذين يعيشون خلاياتٍ وهمية، بأن الجهاد: معناه الحرب الكونية؛ فحين يسأل، يقال له: (ما حكم رجلٍ مجاهد، قام بعملٍ جهادي لوحده، في بلدةٍ من البلاد، ودولةٍ من الدول؟)؛ فيقول لك: (ماذا سيصنع هذا الرجل؟ ماذا سيغير من الواقع؟ هو رجلٌ لوحده، مات وانتهى!).
هكذا ينظرون إلى القضية، هكذا ينظرون إلى المسألة؛ وهذا باطلٌ من القول، هذا قول رجل لا يعرف سنة الله، ولم يقرأ دين الله قراءةً واعية، ولم يقرأ سنة الله، في الكون والحياة، في التاريخ قراءةً واعية؛ هل تظنون أن الصليبيين، عندما جاؤوا إلى بلادنا، في القرن الخامس والسادس الهجري، فاستقروا في البلاد؛ هل خرجوا بحربٍ كونية؟ هل خرجوا بجيوشٍ جرارة؟
ولذلك لا أريد أن أفصل، في فساد الكتاب المتبنى الآن، ويفرح به؛ وهو كتاب (هكذا ظهر صلاح الدين)، أو (هكذا ظهر جيل صلاح الدين)، لرجل يسمى حسن الكيلاني؛ هذا كتابٌ من أفسد الكتب، في تصور الواقعة، لنصرة المسلمين على الصليبيين، وطردهم من البلاد؛ تصورٌ فاسد.
إن الذي قضى على الصليبييين، وأخرجهم من بلادنا، إنما هي جماعاتٌ صغيرة، وتنظيمات؛ إما تنظيمات بقيادة مشايخ، وإما تنظيمات بقيادة قبائل، ولكنها مسلمة، وإما تنظيمات بقيادة مدن، وإما قيادات أو تنظيمات بقيادة حصون، وكانت متفرقة أوزاعًا؛ هذه القرية تقاتل لوحدها دون انضمام، لا يوجد خليفة، لا يوجد للمسلمين خليفة.
كان أمر الخليفة؛ خليفةٌ في القفص، بين وصيفٍ وبُغاة، لا يقول إلا كما تقول الببغاء؛ لا يوجد خليفة، لا يوجد دولةٌ شاملة، تجمع بلاد المسلمين في المشرق والمغرب؛ لا، كانت مدينة تتحرر فتقاتل، وكان حصنٌ يحكم من قبل المسلمين، من غير الروافض، ومن غير الشيعة، ومن غير المبتدعة؛ فيقاتلوا الصليبيين، وعلى ضوء ذلك، بهذه الجماعات الصغيرة، قُضي على الصليبيين؛ وخرجوا من بلادنا.
حتى قيض الله -عز وجل- رجلًا، قاتل هذه البلاد؛ بعضها قاتلها قتالًا، وبعضها دخل في سلطته بإمره؛ فاستطاع أن يقوم ببعض الأعمال، لا بإخراج الصليبيين، كما هو الشأن، في نور الدين الزنكي، وكذلك آل زنكي؛ وكما هو الشأن في أمر صلاح الدين؛ ولكن ما كاد صلاح الدين أن يموت، حتى وزع البلد على أبنائه، وضعف شأنهم، وانفرط عقد الإسلام من جديد.
أي العقد الجامع بين هذه المدن، وهذه الحصون، وهذه التنظيمات، بهذه الطريقة؛ طريقة الأفراد، وطريقة الجماعات الصغيرة، وطريقة التنظيمات؛ حتى ولو كانت متفرقة، سيبقى الإسلام، هو الذي يحمي الإسلام، هو الذي يحمي أهل الصلاة.
إن لم يكن في نظرنا القاصر، أن دولة الإسلام ستقوم عن قريب؛ بسبب عملٍ من أعمال الجهاد، في بلدةٍ من البلاد، وفي دولةٍ من الدول؛ فلننظر إليه، أي إلى هذا الجهاد؛ إنه هو الوقاية، الذي يحمي الإسلام، ولو فردي، من أن يندثر. الأعمال الجهادية؛ هي التي تحمي صلاة المصلين، هي التي تحمي زكاة المزكين، هي التي تحمي حج الحاج، هي التي تحمي ذكر الذاكر.
الأعمال الجهادية، فإن قيض الله لها تمام البركة، وتمام الخير؛ صنعت دولة الإسلام، وحينئذٍ، علينا أن نُغيب من أذهاننا، معنى دولة الإسلام، بالمفهوم الذي طرحناه؛ أنها لا يمكن أن تكون دولة، حتى تكون شاملةً لدولٍ كثيرة؛ ومن فساد قولهم: أن بعض البلاد لا تصلح لدولة الإسلام، كان مما قاله بعض قادة جماعات الإخوان المسلمين في الأردن: (أن الأردن لا تصلح لإقامة دولةٍ إسلامية).
وهذه النزعة، سرت في كثيرٍ من أفرادهم وشبابهم وقادتهم؛ لأنهم ينظرون إلى الدولة الإسلامية، أنها لا يمكن أن تصلح، إلا أن تكون في أمريكا؛ أما في دولةٍ صغيرة، هذه لا تصلح أن تكون دولة إسلام؛ لأنهم لا يعرفون معنى دولة الإسلام، يظنون أن دولة الإسلام؛ هي دولة الغِنى، هي دولة الترف، هي دولة الدَّعى، هي دولة السكون، هي دولةٌ لا تتحرك؛ ميتة مثل بقية هذه الدول.
وما دروا عن دولة الإسلام، التي أقامها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ وما دروا عن دولٍ قامت في أقاصي البلاد؛ ينظروا إلى الدولة التي أقامها عبد الله بن ياسين، ليقرؤوا تاريخ دولة المرابطين، ليقرؤوا تاريخ دولة الموحدين، عندما أقامها المهدي بن تومرت؛ وإن كان عليها ما يقال، في عقيدة صاحبها ورجالها.
ولكن لينظروا تاريخ إقامة الدول، بل لينظروا تاريخ إقامة الدولة العباسية؛ الدولة العباسية قامت في أقاصي الجبال، فهذه هي سنة الدول؛ لأن الدول لا تستطيع أن تنشأ وترعرع، لا يمكن لها أن تنشأ الدول، في وسط قوة الكفر؛ وإنما ربما تقوم على الأطراف، الضعيفة، المهيبة الجانب، المهينة النظر من قبل الأعداء، دولة لا قيمة لها؛ يقيموها هناك، بعيدًا عن الدول.
ولكن عليكم أن تحفظوا، الدول القوية من البترول، والدول الغنية، بهذه المناطق الضعيفة، التي لا يأبه لها؛ يمكن أن تنشأ وترعرع دولة الإسلام، وهذا ليس أمرًا خفيًا؛ بل قد تقوم في دولةٍ، من صلب الكفر، وأهل الكفر؛ فعلينا أن لا نحتقر، ولو مدينةً حررت، ولو قرية غنمها أهل الإسلام، وبسطوا فيها سلطان الله.
علينا أن لا نحتقر، ولو جبلًا استطاع أهل الإسلام، أن يمكنوا لأنفسهم فيه؛ فهذه هي البدايات الصحيحة. فإن وقع توفيق الله، وجروا على سنة الله، وقع الموعود الإلهي، بنصر المسلمين، ودخول هذا الدين في كل مكان؛ أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
نسأل الله -عز وجل- أن يغفر لنا، وأن يتوب علينا، وأن يرحمنا، وأن يقيم لنا دولة إسلامية؛ دولة فيها حكم الإسلام، وحكم أولياء الله -سبحانه وتعالى؛ ليخرجنا من هذه البلاد، بلاد المقت والعذاب.
اللهم اغفر لنا، وارحمنا، وتب علينا، وأصلحنا، ووفقنا، واجعلنا من أهل طاعتك، ومن أجل عبادتك؛ يا أرحم الراحمين.

