بسم الله الرحمن الرحيم
مجموعة البُشْرَيات
قِسْمُ التَّفْرِيغِ وَالنَّشْرِ
تفريغ خطبة
القلب مكان المعرفة
للشيخ: أبي قتادة عمر بن محمود
من سلسلة دروس الشيخ أبي قتادة القديمة
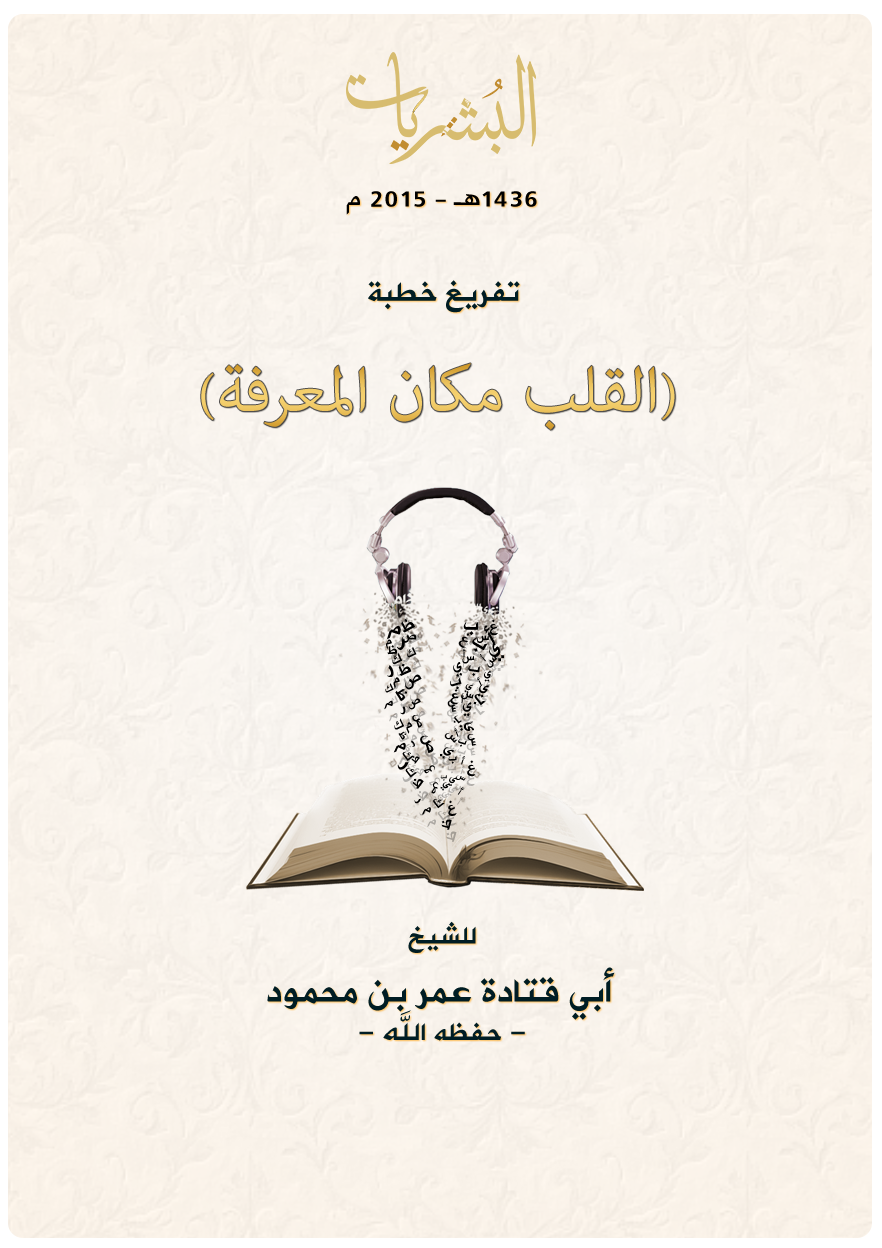

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المحِجَّة البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكَّبُها إلا ضال. أما بعد:
من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا بعيدًا.
أيها الأحبة في الله! كان من نظرات أهل العلم في كتاب الله -سبحانه وتعالى-، أنهم لم يجدوا فيه ذكرًا للفظ (العقل) لفظًا مستقلًا، على الرغم أن محاولات الأوائل، ممن عُدوا من قادة البشر، أو من أصحاب النظر الثاقب؛ كان اهتمامهم الرئيس بقضايا العقل، ومسائل الذهن، حاول بعضهم من أجل أن يسد هذه الفجوة فيما ظن، في كتاب الله -عز وجل-، وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ بأن ذهب وألف أحاديث متعددة في فضل العقل، ونسب هذه الأحاديث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ولكن النقاد والجهابذة، الذين أقامهم الله -عز وجل-؛ لتصفية العلائق الكاذبة، في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كشفوا هذه الزيوف، وقالوا فيما قالوا: أنه لا يوجد حديثٌ صحيح في فضل العقل، لا يوجد حديثٌ في فضل العقل؛ إنما هي أحاديث ملفقة مكذوبة، فأين إذًا مدار الفهم؟ نعم، جاءت بعض الآيات التي تمدح العاقلين، لكن لم يوجد مدحٌ قط للفظ العقل، ولا لذكره كلفظٍ مستقل في كتاب الله -عز وجل-، وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ولما بُحِث في الكتاب عن الأمر، الذي علق الله -عز وجل- عليه الفهم؛ وجدوا أنه معلقٌ بالقلب، والناس حين يقسمون كينونة الإنسان (ماهيته)، فإنهم يجعلون المشاعر والوجدان (الحب والكره) للقلب، والرضا والغضب للقلب؛ وحين يقسمون أويجعلون مرتبة الفهم والإدراك والتمييز والحب؛ وهي المراتب الأولى التي يقال عنها مرتبة الإدراك، وهي التي تميز الإنسان في مسيرته، لإدراك ما خلق الله من معلوماتٍ ومن أشياء.
فيقولون:
إن أول مرتبة: هي مرتبة الإدراك.
والمرتبة الثانية: هي مرتبة الحب.
والمرتبة الثالثة: هي مرتبة التمييز.
والمرتبة الرابعة: هي مرتبة التركيز.
هذه خصائص الإنسان في فهمه للأمور؛ جعلوا هذه الأمور منوطةً بالعقل، ولكن القرآن الكريم يجعل القلب هو مناط الفهم، وكذلك سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ومن ذلك قوله -سبحانه وتعالى-: {إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ}، ومن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب).
ومناط الفساد في الوجود معلقٌ بالجهل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح، يقول: (اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علمٍ؛ فضلوا وأضلوا)؛ فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الضلال والإضلال معلقٌ بالجهل. إذًا الفساد يبدأ بالجهل، والفساد معلقٌ بالقلب؛ إذًا مناط أو مكان الفساد، ومكان الجهل، ومكان العلم هو القلب؛ فلماذا هذا الأمر الذي امتاز به الوحي، عن بقية مدارك البشر؟ وهل لهذه المسألة أهمية، في دعوة الناس إلى الله؟ وفي إصلاح حياتهم؟ وفي إخراجهم من الظلمات إلى النور؟ هل لهذه أهمية من أجل إخراج الناس؛ من مسائل الضلال إلى مسائل الهدى، ومن مرتبة الغي إلى مرتبة الإبصار، ومن مرتبة الذلة إلى مرتبة العزة؛ هل لهذه القضية مسألة؟ هل لهذه القضية تعلقٌ بهذه المسائل؟
الجواب: ولا شك نعم. صحيحٌ أن بعض الناس ربما لا يرى فيها قضيةً عملية، إنما هي مسألةٌ علمية؛ أن يقف معلمٌ أو شيخ أو واعظ فيبين هذه المسألة؛ أن مكان الجهل هو القلب، و مكان العلم هو القلب، ليس هو العقل؛ ويقف عند هذه المسألة المجردة، باعتبارها أنها مسألة من المسائل، التي يتميز بها الوحي عن مدارك البشر، وعن إفرازاتهم؛ ولا يرى في هذه المسألة أهمية عملية؛ في بناء الفرد المسلم، وفي بناء الجماعة، وفي قضايا الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-.
ولكن أيها الإخوة الأحبة! هذه من القضايا العظيمة، وأئمتنا أصابوا فيها الحليف الطويل، وكانت كتبٌ قد ألفت في هذه المسألة، وممن ألف فيها وأصاب، هو الإمام الجهبذ أحمد بن تيمية -عليه رحمة الله-؛ عندما جعل من أسس المسائل الفارقة، بين أهل السنة وبين الأغيار، في تعريف ماهية العقل؛ ما هو العقل؟ وهي مسألةٌ تسير في الناس هذه الأيام، الناس يقولون أنه لا يحصل، وكذلك الدعوات والجماعات والأفراد؛ إنها تقول، والكثير منها يقول: أنه لا يحصل، ولا تحصل النهضة، ولا يحصل الخروج من الواقع الآسن، المليء بالذلة إلى العزة؛ إلا بحصول مرتبة الإدراك العقلي.
وهنا يقتصرون على قضايا تسمية ما جاءت به الشريعة، يقولون أن الإسلام لا يصلح أن يُبدأ به إلا بعقيدةٍ عقلية؛ ولذلك ترى الإصابة الشديدة في قضية ما يسمى ب(إسلامية المعرفة) مثلًا، وهي قضيةٌ تشغل بال الكثير؛ من المشايخ، ومن الدعاة، ومن الوعاظ، ومن الذين يهتموا في حركة الأمة، وفي إصلاحها، وفي إخراجها مما هي فيه.
أيها الإخوة الأحبة! نعود إلى قضيتنا فنقول: إن الشارع الحكيم قد علق الصلاح بالقلب، وجعله هو مكان المعرفة؛ لأنه لا قيمة للفكر، ولا قيمة للمعارف المعنوية، ولا قيمة للعلوم الذهنية، ما لم تكن هذه تحصل حركة إرادية للإنسان، في سلوكه وعمله؛ فليس الإسلام مجموعة من المفاهيم، وليس الإسلام هو مجرد عقيدة، وليس الإسلام هو مجرد مفاهيم تلقن للأتباع، وتدرس على الألواح، وتقدم بطريقةٍ رياضيةٍ للناس؛ لكن هذا الدين هو دين قلب، أي دين إرادة؛ المسألة هي في إرادة الإنسان.
ولذلك لم يبحث القرآن الكريم فيما قاله أئمتنا، فيما قاله الأخيار، لم يتكلم القرآن الكريم في قضية الألوهية: أي ألوهية الرب ووحدانيته؛ لم يناقشها تلك المناقشة العقلية، التي يفعلها الناس في مجالسهم، ويكتبونها في كتبهم؛ لأنها ليست بتلك المسألة العظيمة، ولا بتلك القضية التي هي أساس مشكلة الإنسان، مشكلة الإنسان هو الهوى؛ قال الله -عز وجل-: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى}، فجعل القرآن الهدى مقابل الهوى، وكذلك قال الله -سبحانه وتعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ}، فالهوى جعله الله مقابل الحق، وجعله مقابل الهدى.
إذًا غلطُ الإنسان، سقوطه، تخلفه عن مرتبة العبودية الضرورية في رضا الرب -سبحانه وتعالى-، إنما تقع بسبب الهوى، لا بسبب عدم المعرفة؛ فقد تقنع الرجل وتبين له بمسائل الحساب والرياضة؛ أعظم المسائل، وأجلى القضايا، ولكنه يرتكس بعدم إبصاره الطريق، وبعدم دخوله في العمل المطلوب، الذي أمره الله -عز وجل- به؛ لذلك: {إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ}، كيف تحصل الذكرى؟ انتبهوا لهذه الكلمة! قال عن القرآن أنه ذكرى، والتذكير لشيءٍ معلوم؛ فإذًا الإنسان ليس بحاجةٍ إلى قضيةٍ تعليميةٍ جديدة، ولكن بعث الأنبياء من أجل تحصيل الذكرى.
هذه الذكرى التي يعرفها الإنسان بفطرته، ولكنها احتاجت إلى تثويرٍ، بذكرى لا بتعليمٍ جديد؛ فالقرآن ذكرى للإنسان، بأن يبصر الفطرة التي غيرها، لا بالجهل فقط، ولا بعدم الإدراك، ولكنه بحاجةٍ إلى الذكرى؛ التي تحصل بها الإرادة، والتي تحرك الإنسان بعيدًا عن الهوى: {إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ}؛ هذا القلب لمن كان له قلب، هذا القلب أيها الأحبة! ضرب الله -عز وجل- به مثلًا عظيمًا، ومثلًا جليلًا، هذا القلب حين لا يمتلئ بالران، ولا يرتكس لا بالجهل؛ ولكنه يرتكس بالهوى، يرتكس في هواه لا في جهله، ولكنه يرتكس في هواه.
هذا القلب حين يخرج من الهوى، يقول الله -عز وجل- فيه: {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ}، ماذا قال أهل العلم في هذه الآية الجليلة العظيمة؟ هذا الصدر هو المشكاة، والمشكاة: الطاقة في البيت، التي لا تنفذ إلى الخارج، والتي يوضع فيها السُرُج، كانوا يضعون فيها السرج لتنوير البيت.
فمثل نور الله -عز وجل- في قلب المؤمن، {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ}: صدر المؤمن، {كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ}: ما هو هذا المصباح؟ هو قلب المؤمن؛ صدر المؤمن هو المشكاة، والمصباح هو قلبه، {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ}، هذا القلب له جدران، إما أن تتكدر فتسود، وإما أن تلمع فتبصر الحقائق كما هي: {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ}، هنا حديثٌ عن القلب الذي لم تخالفه الأهواء، قضيةٌ تتعلق بالقلب.
{مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ}، بم يوقد هذا؟ {يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ}، ما معنى هذه الآية؟ قال أهل العلم: أن المؤمن أو الإنسان الذي لم تخالطه الأهواء، يقدر الله -عز وجل- له أن يهتدي إلى الحق، ولو لم يأتِ إليه الوحي، فهو يبصر الحقائق؛ لنوره، وإن لم يأتِ إليه النور الخارجي، أي نور الوحي؛ فـ{يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ}، أي ولم يأتِ إليه الوحي، فهو منيرٌ مضيءٌ مشرقٌ، لا وسخ فيه ولا قذر: {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ}، ولكن لرحمة الله جمع له النورين؛ نور الوحي، ونور القلب: {نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ}.
إذًا القلب هذا هو مناط المعرفة، التي تتحقق بها حركة الإنسان، وتحرير إرادته من الأهواء والشهوات؛ للوصول به إلى مقصد خلقه، وهو تحقيق العبودية لرب العالمين. فأي علمٍ لا يحقق هذا المقصد، لا قيمة له عند الله -سبحانه وتعالى-، وأي معرفةٍ لا يزداد بها المرء طاعةً لربه، وإقبالًا على العبودية؛ فهي لا قيمة لها، بل ربما يرتكس فيها، فيُؤوِّل العلم إلى صالحه وإلى هواه، فيصبح العلم طامةً عليه.
فالذكرى لا تحصل إلى بالقلب، قال أهل العلم: {لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ}؛ أي هذا القلب المخصوص، وليس أي قلب؛ {أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ}. القلب الذي يحصل فيه النور، هو القلب الذي لم يتسخ؛ فقال: لم أتى الله -عز وجل- بلفظ التخيير (أو)؟ ولم يأتِ الله -سبحانه وتعالى- بلفظ واو الجمع؟ فهو بحاجة إلى القلب، وبحاجة إلى السمع، وبحاجة إلى عدم وجود المانع: {أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ}؛ الشهيد هنا ليس بمعنى الحضور، ولكنه بمعنى الإقرار؛ فالشهادة تأتي بمعنى الحضور: شهدت الشيء أي حضرته، وتأتي بمعنى الإقرار: كما يقول الرجل الآخر: شهدت أن لك علي مئة دينار؛ فهذه ليست حضور، لكنها إقرار منه. فهو أتِيَ هنا أيها الأحبة بلفظ التخيير، لماذا؟ قال: {أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ}.
لمن لم يكن له هذا القلب؛ فكيف يجليه؟ كيف ينظفه؟ كيف يصلحه في عبادته لرب العالمين؟ لا بد أن يُلقي سمعه إلقاءً به يحصل الإقرار، وليس بمجرد العلم. أرأيتم أيها الأحبة! لا تحصل الذكرى وهي مقصد القرآن، إلا بالشهادة، وليس بإلقاء السمع فقط، لا بد من أن يحصل مع هذا السمع الشهادة؛ وهو أن يتلقى ما أمره الله -عز وجل- به، على جهة الإقرار به، والتعامل معه، على أنه علمٌ رباني، ما أوتي إلا من أجل أن يمتثله.
فصلاح الناس أيها الأحبة! لا بد لهم أولًا من العلم، هذا مما لا شك فيه؛ ولا يمكن أن تخرج الأمة من فسادها، ومن ذلتها، ومن ارتكاستها، لا يمكن إلا بحصول العلم؛ الذي يحصل به ليس المعرفة، العلم الذي يحصل به الهدى، هذا العلم الذي يكون مداره، ويكون مكانه هو القلب، الذي تتحقق فيه الذكرى.
ولذلك صار هناك على مدار التاريخ منذ الأزل، يقولون أن للخطاب طريقتين: الطريقة الاولى، التي يقولون عنها (المنطقية)، أو التي تسمى ببعض الإحسان بـ(البرهانية)؛ وهي التي ترتب المعلومات على طريقة الرياضيات (1+1=2)، معلومة تحصل في العقل، معلومة تستقر في الذهن، وليس لها أي دورٍ في إرادة الإنسان؛ لأن مكان الإرادة إنما هو القلب؛ الإرادة تحصل في القلب، لا تحصل في العقل، قالوا: إن هذه الطريقة الأولى هي الطريقة (البرهانية)، هذه الطريقة هي طريقة ترتيب المعلومات، على طريقة الرياضيات والحساب؛ لتحصل فيها المعلومة، على طريقة العلم الصافي المجرد.
وهناك الطريقة الثانية: وهي الطريقة (الخطابية)، أو التي يقال لها (الإنشائية)؛ وهي طريقة الوعاظ، وطريقة السياسيين في تثوير الناس، حتى إنهم قالوا فيما قالوا: وهي طريقة الأنبياء، وقالوا: هذه طريقةٌ تحصل لعوام الناس، وتحصل لغمارهم، ويتأثر بها البسطاء.
أما هم؟ فأهل العقل والفكر، أما هم؟ فأهل المنطق والتفكير، الذي لا يهتم بوجدان الإنسان، من حبٍ وكره، ولا بالرضا والغضب، ولا تعلق بضلال الناس بسبب الهوى؛ إنما بسبب عدم العلم، فإذا تحقق العلم المجرد، فقد حصلت هداية الإنسان. والصحيح في هذا كله، هي طريقة القرآن أيها الأحبة! الطريقة التي فيها الزجر إن اقترفت المعصية؛ حين يأتي القرآن الكريم ويتحدث عن جهنم، من أجل أن يردع هذا القارئ، هذا التالي لكتاب الله، من اقتراف المعصية.
حين يأتي القرآن ويتحدث عن الجنة، ويرغبك بفطرةٍ سائقةٍ بقوةٍ إلى الطاعة؛ فيكشف لك ما أعد الله لك في الجنان مما ذلك؟ يرغبك لأنه وهو العالم فيك بما تتحرك؛ رغبك أن تُقبل على الطاعة بالحور العين، ورغبك بذكر الأنهار؛ ذكر أنهار الخمر، وأنهار العسل، وأنهار المياة، وأنهار اللبن. زجرك عن المعصية؛ بذكر النيران وشدة حرقها، وشدة إيذائها، رغبك بهذا؛ لأنه لا تحصل حركة الإنسان إلا بهذه المواعظ.
وأما تجريد المفاهيم عن هذا، لمجرد حصول المعلومات في العقل فقط؛ فهي طريقةٌ تكثر معلومات الرأس حتى يتبخر، ولكنها لا تحصل بها الإرادة، إلى صلاة الفجر جماعة؛ أي قيمةٍ للعلوم العقلية، إذا لم تدفع الإنسان، إلى أن يخرج من فراش نومه؛ ليتوضأ ويصلي صلاة الفجر جماعة؟ أي قيمةٍ لعلومه؟ أي قيمةٍ لعلومه، إذا لم يعلم أن هذا الدين، هو دين مواجهة؟ العلم في العقل؛ يريدون به أن يحصل الحوار!
انظروا إلى نتائج ما يريدون أن تحصل به طريقة البرهان والمنطق! يريدون أن يبقى الحوار مع الخصوم، لا على أساس المواجهة، ولكن على أساس المنظر الواحد؛ المسلم منظره كمنظر الكافر، يجتمع المسلم مع الكافر في جلسةٍ فكريةٍ عقلية، يجلس كل واحدٍ منهما على الطاولة، هذا يخرج ورقته وهذا يخرج ورقته؛ ليتم الحوار، الحوار الموضوعي؛ الذي لا يحصل به الصدام، ولا يحصل به المناكفة، الحوار الذي يتم به تعريف كل فكرةٍ إلى الآخر، مع قضيةٍ أخرى، تختلط في هذا الجو القبيح؛ هي (نسبية الحق).
كيف هي نسبية الحق؟ وهو أن يعترف كل واحدٍ للآخر، أنه يرى المسألة من جهةٍ أخرى؛ فكما قال بعضهم: هي كالكرة، نصفها أبيض ونصفها أسود؛ فهذا الذي في الجهة الأخرى رأى نصفها الأبيض، اعترف أن الآخر لا يراها بيضاء، إنما يراها سوداء (نسبية الحق)؛ ولذلك القرآن لم يقل فقط عن نفسه أنه علم، أن يحصل فيه العلم؛ هذا الإسلام لا يسمى فكرًا ولا يسمى عقلًا، هذا القرآن وهذا الإسلام يسمى دينًا.
و الدين ليس هو العلم؛ الدين: هو الخضوع، هو الامتثال، هو الطاعة، التي تصبح حركةً في الدنيا؛ ليصبح فيها الصدام، ليصبح فيها الحرب، ليصبح فيها التجاذب بين رجلٍ يستفزه الشيطان؛ كما قال الله: {تَؤُزُّهُمْ أَزًّا}، يشتد غليان النفس، الشيطان يؤزهم، الأزّ: هو غليان الماء، ارتفاع الماء لشدة الغليان (يؤزهم)؛ والحق في داخلك، يؤزك إلى الحقد على الباطل، إلى الحقد على الشر، الحقد حتى يتم الصدام؛ وهذا يمثل دينًا، لا صدامًا فكريًا؛ كلٌ يرمي ورقته إلى الآخر، وكلٌ يناظر الآخر؛ لكنه صدامٌ يحصل فيه الدم، وتحصل فيه الحرب، ويحصل فيه القتال.
لماذا؟ لأن مكان كل علمٍ؛ إنما هو القلب، هو الحب، هو الكره، هو الرضا، هو الغضب. العلم الذي يحصل به حركة الإنسان؛ فيتفاعل فيه، وفي عمله، في أخذه، في رضاه؛ إنما هو متفاعلٌ مع هذا العلم، وذاك متفاعل مع الشر، هذا يتفاعل من أجل تحقيق الرضا الإلهي، وهذا يتفاعل من أجل إرضاء شيطانه؛ فيحصل ما قدر الله في خلقه من الصدام.
يريدون أن يحولوا الإسلام إلى فكرة، تحتمل هذه الفكرة وجود المخالف؛ لأنه رأى المسألة من وجهٍ آخر –انقطع الصوت- {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}، ليحصل الخصام، الإسلام ليس فكرة لتقابل الآخر، الإسلام حقٌ جاء ليخاصم الآخر، جاء ليقاتل الآخر، جاء ليرفض الآخر، جاء ليقول له: أنت إن لم تأتِ إلي فأنت كافر، إن لم تأتِ إلي فأنت عدُوي، إن لم تأتِ إلي فأنت في جهنم.
أي دينٍ هذا الذي يدخل الناس الجنة، وهم ليسوا معه على الإسلام؟ فكرة! فكرة يعايشها الناس، وعقيدة تختمر في العقول، ولا تحرك شيئًا من الأبدان؛ هذا ليس بالدين المطلوب، هو دينٌ بارد، هو فكرة كفكرة الفلاسفة (المشائين)، سموا ب(المشائين) أيها الأحبة! لأنهم كانوا يمشون ويتناظرون، يمشي هذا مع خصمه ويتناظر هو وإياه، ثم تنتهي المسألة بقول الواحد للآخر: إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية؛ أنت نظرت إلى الكرة من جهةٍ بيضاء، فاعذرني فأنا أراها من جهةٍ سوداء، ماذا وقع؟!
دائمًا أيها الأحبة! دائما هذا الوجدان، هو أساس حركة الإنسان، هذا القلب (الحب والبغض)؛ هو تحقيق العبودية لله -عز وجل-. لكن انظروا إلى شاب قليلٍ العلم، لكن يتفاعل مع هذا العلم؛ وجدانًا حبًا وبغضًا، هذا إنسانٌ محتقر، لدى من؟ لدى أولئك الجهابذة، الذين يسمون أنفسهم بالمفكرين. هؤلاء جماعة الفكر، جماعة العقل! فإذا نظروا إلى هؤلاء الشباب الذين يطيلون لحاهم، ويصادمون الغير مصادمة؛ قالوا: هؤلاء دهماء، هؤلاء غوغاء، هؤلاء جهلة، هؤلاء بقر، مجموعة من البشر لا قيمة لهم؛ أما هم فهم أهل الفكر! أهل الفكر!
أي موازنة يقولون؟ أي موازنة حضارية؟ وبئست هذه الكلمة، التي صارت تستخدم على باطلٍ أكثر من استخدام أهل الحق لها؛ يقولون أي موازنةٍ حضارية؟ بين هذا المنظر الذي جلس فيه الجميع على الكراسي الأنيقة، ولبسوا الألبسة الجميلة، وجلسوا يتناظرون، مناظرة المفكرين ومناظرة العقلاء، وكل واحدٍ يخرج فكرته، ويتكلم بما شاء، ويسمونها المعارك! وبين أولئك؛ انظر إلى هؤلاء، إلى مناظرهم، شعثًا غبرًا، لا يفهمون إلا لغة الدم ولغة الضرب، لا يتحروكون؛ انظر! إلى هؤلاء وإلى هؤلاء!
أما الصورة الأولى: فهي الصورة الحضارية! صورة حضارة الثقافة، والفكر، والمناظرة؛ وهذه الصورة الأخرى: هي صورة الجهالة، صورة الأغبياء؛ ماذا عندهم من العلم؟ هذا رجلٌ يحفظ المعلقات، وهذا رجلٌ يحفظ المنطق، وهذا رجلٌ يتناظر في أكبر المسائل؛ أما هؤلاء، فانظر إليهم؛ فعامة مسائلهم (ك ف ر، ذ ب ح)، وهكذا فقط، لا يفهمون إلا هذه الحروف الستة: (كفر، ذبح، سيطر)؛ ومع ذلك فأرض الواقع تنبؤنا أيها الأحبة! على أنهم لم يسيروا أفكارهم إلا بسلطان القوة، وإلا بسلطان السيطرة!
علينا أن نفهم، أن هذا الدين، إنما هو دين أولئك الذين يتفاعلون معه؛ يُسْلم الرجل منهم ويخرج، وقد عادى أهله، وخرج من بيئته، وعادى والده، وعادى أباه، وقاتل مجتمعه، وخرج وهو يعبر عن وجدان، وصل إلى درجة اتهامه بالجنون، وإلى درجة اتهامه بالخبل، وإلى درجة اتهامه بعدم الثقافة؛ إنه مجنون لماذا؟ لأنه يتفاعل مع هذه الفكرة، كأنها صارت هو، وهي صارت هو؛ ملتصقة به.
بين رجلٍ آخر، تعال إلى الإسلام الحضاري، وهو إسلام حرب الثقافة، وحرب العقول، وحرب الفكر؛ ولكنه يقول الله -عز وجل- عن نتائج الأمر يوم القيامة، يقول: {وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ}؛ المتدين أيها الأحبة! هو الذي يعيش الإسلام، بحبٍ وكره، برضا وغضب، بحقدٍ على ما أمر الله أن يحقد عليه؛ هذا حركة، هذه حركة، هذا عمل، ليس هو إسلامٌ آخر؛ يستطيع الواحد منهم أن يؤلف المجلدات، ويعجز أن يخرج إلى صلاة الفجر، أو أن يقاتل الآخر، أو أن يصادم الآخر، يجبن عند اللقاء، بخيلٌ عند العطاء.
هذا ليس هو الإسلام الذي دعا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فليس في الإسلام عقل، ليس في الإسلام عقل، في الإسلام عقلاء؛ ولكن ليس هناك شيءٌ اسمه العقل المجرد الجامد، الذي يغذى بالمعلومات، فيبقى عظيمًا كقبة المسجد؛ يريدون منا عقولًا كقبة المسجد، وأرجلًا في الحركة مثل أعواد الكبريت! تصور أن رجلًا رأسه كقبة المسجد عظمة، وأرجله مثل عيدان الكبريت، فهو دائمًا مجفيًا على رأسه، لا يتحرك إلى الإسلام، ولا مع الإسلام!
أيها الإخوة الأحبة! ما يقال في هذا العصر، قد قيل على مدار تاريخ الأنبياء؛ الأنبياء، لماذا كان عامة أتباعهم هم الفقراء؟ لماذا قال الملأ من قريش: (أخرج هؤلاء الضعفاء)؟ لأنهم يريدون أن يقلبوها إلى مناظرةٍ فكرية، لاحتمال وجود الآخر؛ أما هذا المسكين، هذا الضعيف؛ هو لا يفهم هذا، إنما يفهم إسلامًا حقيقيًا، يتفاعل معه، ومع هؤلاء المجانين؛ لفظ المجنون، قد أطلق على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ومن إحدى كذلك صور الإطلاقات أن فارس، وفارس هي فارس، فارس: هم القوم الذين يهمهم قوة العقل، والإدراك، وقوة اللسان؛ جماعة مثقفة، لما رأوا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: ديوانا، أي مجانين مجانين، ديوانا ديوانا، مجانين مجانين؛ هؤلاء هم البسطاء، هم الذين يصنعون التاريخ، وهم الذين يحققون الإسلام على أرض الواقع؛ هؤلاء الضعفاء هم الذين يصنعون ما أحب الله، هم الذين يحققون الإسلام في الأرض.
أما أولئك، فهم لا يحققون الإسلام في ذواتهم، يتكلمون عن أعظم القضايا في الإسلام؛ وهو لا يستطيع أن يحقق الإسلام في ابنته، ولا أن يحقق الإسلام في زوجته، لا يفهمون التدين، لا يفهمون الدين تدينًا وخضوعًا، إنما يفهمونه فكرة، يفهمونه أفكار؛ فهم بلا شك عقلاء، وهم بمفهموهم بلا شك مفكرون، وهم بلا شك عقولهم كبيرة، ولكن عقولهم تعجز أن يعلم ابنه الفاتحة، أو يعلم زوجته حديثَا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بل يرى هذا من تمام التخلف، وهذا لا قيمة لها.
إنما عليها، وعلى زوجته، وعلى ابنته، وعلى ابنه، أن يتمرس في علوم الآخرين؛ ليصبح هذا الإنسان، الذي يلبس البدلة الجميلة، ويتحرك في الإسلام فكرة، أفكارًا تلوكها ألسنتهم، دون أن يتحقق دينًا، في حياتهم على مدار التاريخ، كان احتقارٌ لأتباع الأنبياء، كان احتقارٌ لأولئك الذين أصروا أن يخضعوا لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دون اهتمامٍ لما يقال من مسائل العقل؛ اتهم أهل الحديث بأنهم جامدون؛ يأخذون أهل الحديث، ويعملون به، وهؤلاء ممدوحون عند الله -عز وجل-.
أما أولئك؛ فهم أهل العقول، الفلاسفة اتهموا أهل التدين بأنهم مجانين، حتى وصل فيهم الأمر أن يقولوا عن أولئك المتدينين، الذين لا يستطيع الواحد منهم، أن يركب -ما يقال له بالمنطق الصوري- أن يركب مسألة منطقية، يقولون عنهم: (هؤلاء ليسوا بمسلمين)، سلبوا منهم الإسلام؛ لأنهم عجزوا كما يقولوا؛ لأن هؤلاء الجهلة عجزوا أن يستدلوا على الحقائق بقلوبهم، التي يحصل بها العباد، يحصل بها قيام الليل.
فهذا الإنسان البسيط، يقوم الليل ويبكي أمام الله، والله -عز وجل- يناديه؛ هو لا ينادي ذاك الرجل، يقول (ألا من مستغفرٍ فأغفر له؟)؛ يناديه الرب؛ العلاقة بينه وبين الله موصولة إذا دعاه، إنما هو يدعو ربه، والله -عز وجل- يقول: (ادعوني أستجب لكم). هؤلاء الذين يحققون الأعمال، التي يحصل بها الصلة مع الله، هؤلاء على مدار التاريخ، يحتقرون من قبل أهل العقول، من قبل الذين يريدون أن يجعلوها ألفاظًا تتداول بين الناس، وأفكارًا يحصل بها المناظرة.
أيها الإخوة! تستطيعون بكل وضوح، أن تروا هذه الصور الماثلة، بين المسلم المتدين، والذي يزعم من قبل الآخرين أنه جاهل، وبين الرجل المفكر الآخر؛ الذي يتعامل مع الإسلام، أفكارًا وحوارًا مع الحضارات، وحوارًا بين الأديان، وحوارًا بين المذاهب؛ هذه سنةٌ ستجري في يومنا هذا، كما جرت في الأوائل إلى يوم القيامة.
نسأله -سبحانه وتعالى- أن يبصرنا بالحق، وأن ينور قلوبنا، وأن يهدينا سواء السبيل: {إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ}.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا.
اللهم كفر عنا سيئاتنا.
اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، وميتةً في مدينة حبيبك محمد -صلى الله عليه وسلم-.
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، في برك وبحرك؛ اللهم حقق أمانيهم، بنصر أهل الإسلام، وإقامة دولته، وألحقنا بهم على خيرٍ وهدًى، يا أرحم الراحمين.

