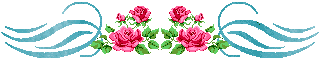توحيد الحاكمية؛ ما هو دليله؟
توحيد الحاكمية؛ ما هو دليله؟
للشيخ العلامة أبي قتادة الفلسطيني
 مقدّمة في صياغة العلوم؛ علم التوحيد نموذجاً
مقدّمة في صياغة العلوم؛ علم التوحيد نموذجاً
ليس من العجب في شيء أن تكون آمالُ المسلمين وأهدافهم لم تأخذ حقّها في الوجود والتطبيق، لأنّ هذه الأهداف ما زالت لم تتشكّل بعد في أذهانهم، إذ يحيطها الكثير من الجهل وسوء المعرفة.
والمشكلة ما زالت كامنة في العلم وليس في الإرادة فقط كما يظنّ البعض، ومن الأدلّة أنّ المشلكة ما زالت في عدم التصوّر الصحيح هو العجز التام الذي يواجهه أهل الإسلام في صياغة العلوم واضطرابهم في اللفظ الصحيح والجملة المفيدة، وأهل البلاغة على اتّفاق أنّ العجز عن الإبانة يرجع إلى العجز عن التصوّر والعلم الصحيح.
يقول ابن تيميّة رحمه الله: (إذا اتّسعت العقول وتصوّراتها اتّسعت عباراتها، وإذا ضاقت العقول والعبارات والتصوّرات بقي صاحبها كأنّه محبوس العقل واللسان) [1].
وحين تكون الأمّة في حالة اقتتال وخصام حول الأطر اللفظيّة تدوك فيها - أي تختصم - حتّى الغرق لهو دليل على أنّ الأهداف ما زالت بعيدة المنال... بعيدة... بعيدة.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
مقدّمة في صياغة العلوم:
يقول ابن تيميّة رحمه الله في معرض ردّه على المنطقيين وذلك في سياق كلامه على القياس المتّفق على قبوله في العقل الفطريّ وأنّه لا ضرورة لتعلّمه، يقول: (فالاستغناء عن جنس هذا القياس شيء وعن الصناعة القانونيّة التي يوزن بها القياس شيء آخر).
وهذا تفريق مهم بين كون الشيء نظريّ أو حاصل تصوّره في النفس وبين كون صاحبه عنده القدرة على التعبير عنه من خلال مصطلحات فنه الذي قُعِّد به وتعارف أهله عليه، وهذا شيء واضح في علوم هذه الملّة، فلو أخذنا النغم الشعريّ الذي سمّي بعد ذلك ببحور الشعر وطبّقنا عليه هذه القاعدة لوجدناها سهلة وواضحة.
والناس في الحقيقة يحتاجون للصناعة القانونيّة حين تغيب العلوم من نفوسهم، ولا يحتاجون لها حين تكون كامنة في فطرهم وأذواقهم، وقد كان من صور تقدّم صياغة العلوم أنّها تحوّلت من شيء فطريّ إلى علم صناعيّ، وفي اللحظة الأولى الفجائية التي تمّ فيها الإبداع لهذه الصياغة كانت هذه النقلة أصيلة كلّ الأصالة ليس للدخن الغريب أيّ دور فيها، وكل قول يقوله أولئك المنهزمون ثقافيّاً؛ في أنّ الأمة استوردت فنّ صياغة العلوم من اليونان وعلى الخصوص من منطق أرسطو هو قول تنقصه الأدلّة.
فهذا القانون الفطريّ في التعامل مع الفقه والذي سمّي بعلم أصول الفقه عندما قام الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى بصياغته لم يحتج فيه إلى قانون واحد ولا قاعدة واحدة ولا مصطلح واحد خارج النفس العربيّة المسلمة، بل تعامل معه تعامل الرجل العربي الذي استوعب قانون اللغة وتعامل الرجل المسلم الذي استوعب علوم الشرع من كتاب وسنّة، وبإدراك متميّز لهذه العلوم، إلى درجة الوضوح الذي تتمّ به القدرة على الإبانة كتب كتابه "الرسالة"، وكان أوّل شيء أدركه في الشريعة هو وحدتها وعودتها كلّها إلى قواعد كلّية مضّطردة.
قال رحمه الله تعالى: (باب كيف البيان؟ والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعّبة الفروع: فأقلّ ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعّبة أنّها بيان لمن خوطب بها ممّن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشدّ تأكيداً بيانٍ من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب).
فهذا النصّ من الإمام الشافعيّ - وهو من هو - ينبيك على القراءة المستوعبة للمتفرّق حيث رأى فيها - دون غيره في درجة الوضوح - أنّها مجتمعة الأصول، متقاربة الاستواء، ودليله لهذا الاجتماع والمقاربة هو القراءة للفروع كافّة أو لنقل أغلب الفروع.
وهكذا كان أمر الإمام الفحل الخليل بن أحمد الفراهيدي في حصره النغم الشعريّ في بحوره المعروفة، وهي نفس طريقة الإمام الشافعيّ حين أرجع الفروع المتشعّبة إلى اجتماع واتّحاد فلم يند عنه إلا الشاذ القليل لنغم العرب في شعرهم ورجزهم، وهو نفس طريقة واضع علم النحو - كائناً من كان؛ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو أبو الأسود الدؤليّ - حين أخرج علومه من حيز الفطرة والإدراك الذوقي إلى حيز العلم الصناعي المعبّر عنه بقانون وقاعدة، وذلك عن طريق إدراكه للفروع المتشعّبة أوّلاً، ودليل هذه الصياغة هي القراءة للفروع وجمع النظير إلى نظيره.
وقد تواطأ الناس على تسمية هذا النوع من القراءة بالاستقراء، وهذا الدليل - أعني الاستقراء - هو دليل فطري تواطأ عليه كلّ العقلاء - مسلمهم وكافرهم - لأنّه من علوم الرياضة والحساب لا ينكره إلاّ من فقد فطرة الله في الميزان والإدراك كما سيأتي.
ولكن ممّا لا شك فيه أنّ كثيراً من المتأخّرين قد أدخلوا قواعد صناعية غير عربية وغير شرعيّة على هذه العلوم، وقد عانى علم أصول الفقه من هذه الاختراقات البدعيّة أكثر من غيره، وكان أوّل من أدخل قانون المنطق الأرسطي إلى أصول الفقه هو أبو حامد الغزالي كما في مقدّمة كتابه في الأصول المسمّى بالمستصفى، وقد كان من عناية الأئمّة في كتب الأصول أنّهم حاولوا جهدهم في التفريق بين علوم الشرائع وبين قانون اليونان وخاصّة في التفريق بين القياس الشرعي الملّي الفقهيّ والقياس المنطقيّ الأرسطي اليوناني.
قال أبو الوليد الباجي في كتابه "احكام الفصول في أحكام الأصول": (ولولا من يعتني بجهالاتهم - قياس الفلاسفة - من الأغمار والأحداث لنزهنا كتابنا عن ذكر الفلاسفة، ولكن قد نشأ أغمار وأحداث جهال عدلوا عن قراءة الشرائع وأحكام الكتاب والسنّة إلى قراءة الجهالات من المنطق واعتقدوا صحّتها وعوّلوا على متضمّنها دون أن يقرؤوا أقوال خصومهم من أهل الشرائع الذين أحكموا هذا الباب وحقّقوا معانيه...).
فصياغة العلوم بطريقة الزمر والقواعد والقوانين هي طريقة علمية لا تقدح في شرعيّتها كونها لم تكن عند أهل هذه العلوم الأوائل، وقبل الخوض في الاستقراء وكلام الناس حوله في كتب أهل العلم فإنّنا ننبّه إلى أنّ الكثير من هذه القواعد لم تحكم صناعتها إحكاماً صحيحاً وخاصّة ما يسمّى عند المناطقة بالحد، وهو التعريف الصناعي لكلّ شيء، فإنّ التعريف الصناعي الذي يقال له الجامع المانع كانت جنايته على العلوم الشرعيّة كبيرة الخطر، وخاصّة عند من اعتبر أنّ الحد هو الطريق الوحيد لإدراك العلوم والتعرّف عليها.
وقد فصّل ابن تيميّة رحمه الله تعالى ومن قبله الإمام المازري والإمام أبو الوليد الباجي الردّ على هذه الطريقة في التحصيل والإدراك، ونحن ننبّه على هذا الأمر لإدراكنا أنّ الطريقة النبويّة في التعليم كان الأغلب فيها هو التمثيل أي ما يسمّى التعريف بالمثال وهو أعلى أنواع التعريف وأوضحها وأقربها للمطلوب.
وهذا له أهمّية أخرى في الدلالة على المباينة والمفارقة بين مقصود الشارع ومقصود المتكلّمين والمناطقة والفلاسفة، فإنّ مقصود الشارع هو الامتثال والطاعة والانقياد وليس حصول التصوّر والمعرفة فقط، وهؤلاء يعتبرون أن التجريد الذهنيّ هو أمر الخاصّة فيسمّون هذه الطريقة الذهنيّة التجريديّة بالبرهان، ولذلك هم أبعد الناس عن التديّن والتقوى، بخلاف أهل الشرع والإيمان.
ومع شيوع طريقة المناطقة والفلاسفة عند المتأخّرين صار التعظيم للعلوم الذهنيّة التجريديّة وحصل الاحتقار والتقليل لعلوم اليد والممارسة، وبهذه الطريقة تدمّرت الأمة في علمها وإرادتها، أو في توحيد الشرع وتوحيد القدر.
الدليل العقليّ: هل هو بدعة وضلال؟!
لمّا كان الاستقراء دليل عقليّ، ومن خلاله ننظر إلى كثير من الأحكام والقضايا هل هي حقّ أم باطل، وكانت كلمة العقل في كثير من البيئات المتواضعة في علومها تثير الاستفزاز.
كما قال ابن تيميّة رحمه الله: (فإنّ من الناس من يذهل عن هذا، فمنهم من يقدح في الدلائل العقليّة مطلقاً لأنّه قد صار في ذهنه أنّها هي الكلام المبتدع) [2].
فإنّ من الواجب علينا أن نبيّن للشادي الفرقانَ بين العقل الذي يوجب علماً ويصح حَكَماً، وبين العقل الذي لا يجوز النظر فيه ولا تصويبه ولا رضاه، وهي مسألة مهمّة في هذا الباب ولذلك لكثرة الزاعمين أنّ العقل يقابل الشرع، أو قول بعضهم عن دليل: إنّه عقليّ، يعني أنّه بدعيّ، وهذا كما سيتبيّن لنا خطأ صريح، لم يعرفه السلف الصالح ولا الأئمة الهداة، ولذلك لم يسمّي السلفُ المبتدعةَ بـ "العقلانيين" كما فعل المتأخّرون، بل قالوا عنهم: "أهل الأهواء"، لا هوى واحد بل أهواء متعدّدة، وذلك أنفة من هؤلاء الأئمّة من إطلاق وصف العقل على البدعة والانحراف.
لكن لمّا كثر كلام أهل البدع في ردّ السنّة الثابتة والتقريرات الإلهية الواضحة بحجّة مخالفتها لما استقرّ في أذهانهم، وسموا ما استقرّ عندهم بالمعقولات، وزعموا أنّها يقينيّة لا تقبل معارضة، كان أن وُجِدَ من ردّ عليهم بأنّ العقل لا يوجب علماً ويجب أن يحال إلى الإهمال في البحث عن الحقّ والهدى.
وهكذا صار الناس في أذهان البعض فريقين:
-
أهل شرع وسنّة.
-
وأهل بدعة وعقل.
فهذا هو منطلق التفريق بين السنّة والعقل.
وممّا يجب التوقّف عنده هنا - لأنّنا نبحث هذا الموضوع من خلال بيئة نسأل الله الستر والعافية فيها - فإنّنا نقول: إن الحلال والحرام والسنّة والبدعة والغيب وما فيه لا يمكن لأحد أن يعرف الصواب فيها إلا بدليل الغيب أي بالوحي أي بالكتاب والسنّة، وهذا نقدّمه وإن كان سيأتي قادماً في مبحث التفريق بين العقل المقبول والعقل المرذول، إلا أنّنا نقدّمه ليطمئنّ السنّي ويقطع عنه الوساوس، والله الموفّق.
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: (واعلم أنّ أهل الحقّ لا يطعنون في جنس الأدلّة العقليّة، ولا فيما عَلِمَ العقل صحّته، وإنّما يطعنون فيما يدّعي المعارض أنّه يخالف الكتاب والسنّة) [3].
وقال أيضاً: (كون الدليل عقليّاً أو سمعيّاً ليس هو صفة تقتضي مدحاً ولا ذمّاً، ولا صحّة ولا فساداً، بل ذلك يبيّن الطريق الذي علم به، وهو السمع أو العقل، وإن كان السمع لا بدّ معه من العقل، وكذلك كونه عقليّاً أو نقليّاً، وأمّا كونه شرعيّاً فلا يقابَل بكونه عقليّاً، وإنّما يقابل بكونه بدعيّاً، إذ البدعة تقابل الشِّرعة، وكونه شرعيّاً صفة مدح، وكونه بدعيّاً صفة ذمّ، وما خالف الشريعة فهو باطل، ثمّ الشرعيّ قد يكون سمعيّاً وقد يكون عقليّاً، فإنّ كون الدليل شرعيّاً يراد به كون الشرع أثبته ودلّ عليه، ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه، فإّذا أُريد بالشرعيّ ما أثبته الشرع، فإمّا أن يكون معلوماً بالعقل، ولكنّ الشرع نبّه عليه ودلّ عليه، فيكون شرعيّاً عقليّاً... وإمّا أن يكون الدليل الشرعيّ لا يُعلَم إلاّ بمجرّد خبر الصادق، فإنّه إذا أخبر بما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيّاً سمعيّاً، وكثير من أهل الكلام يظنّ أنّ الأدلّة الشرعيّة منحصرة في خبر الصادق فقط، وأنّ الكتاب والسنّة لا يدلاّن إلا من هذا الوجه... وهذا غلط منهم) [4].
ما هو العقل المقبول؟
أطلق العلماء على العقل المقبول أسماء متعدّدة تدلّ على معنى واحد سنصير نحوه بعد ذكر بعض أقوالهم:
العقل المقبول سمّاه ابن خلدون في مقدّمته بـ "الفكر الطبيعي" [5].
يقول رحمه الله تعالى: (فإذا ابتليت بمثل ذلك - أي بالتشغيب والجدال بالشبهات - وعرض لك ارتباك في فهمك أو تشغيب بالشبهات في ذهنك فاطرح ذلك وانتبذ حجب الألفاظ وعوائق الشبهات واترك الأمر الصناعي جملة واخلص إلى فضاء الفكر الطبيعي الذي فُطِرتَ عليه وسرّح نظرك فيه، وفرّغ ذهنك فيه للغوض على مرامك منه).
فالفكر الطبيعي عنده هو الفطرة الإلهيّة، وهي ربّانية الخلقة حنيفيّة الأصل وهذه هي مصدر الحقّ، ولذلك يقول: جهة الحقّ إنّما تستبين إذا كانت بالطبع – السابق - ولأنّ الذريعة – الوسيلة - لا تكون إلا بالفطرة.
وإذا عَجِزْتَ وكَلَّتْ عن الجواب الواضح فإنّه يقول: (واستمطر رحمة الله تعالى متى أعوزك فهم المسائل) [6].
يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليماني في كتابه "القائد إلى تصحيح العقائد"، ضمن المجلّد الثاني في كتابه الماتع "التنكيل بما في تأنيب الكوثريّ من الأباطيل" [7]: (مآخذ العقائد الإسلاميّة أربعة؛ سلفيّان وهما الفطرة والشرع، وخلفيّان وهما النظر العقلي المتعمّق فيه، والكشف الصوفي، أمّا الفطرة؛ فأريد بها ما يعمّ الهداية الفطريّة والشعور الفطري، والقضايا التي يسمّيها أهل النظر ضروريّات وبديهيّات، والنظر العقلي العادي وأعني به ما يتيسّر للأمّيين ونحوهم ممّن لم يعرف علم الكلام ولا الفلسفة، وأمّا الشرع؛ فالكتاب والسنّة، وأمّا النظر العقلي المتعمّق فيه؛ فما يختصّ بعلم الكلام والفلسفة، وأمّا الكشف الصوفي؛ فمعروف عند أهله ومن يوافقهم عليه، فأمّا المأخذ السلفيّ الأوّل؛ فالهداية والشعور الفطريّان يتّضحان ويتّضح علوّ درجتهما بالنظر في أحوال البهائم والطير والحشرات كالنحل والنمل).
ويقول رحمه الله تعالى: (وأمّا القضايا الضرورية والبديهية فقد اتّفق علماء المعقول أنّها رأس مال العقل، وأنّ النظر إنّما يرجي منه حصول المقصود ببنائه عليها وإسناده إليها. وأمّا النظر بالعقل العادي فقد اعتدت به الشرائع، وبنت عليه التكليف، ودعت إليه وحضّت عليه، وعلماء المعقول مصرّحون بأنّ الدليل العقليّ كلّما كان أقر مدركاً وأسهل تناولاً وأظهر عند العقل كان أجدر بأن يوثق به) [8].
فالمقصود بالدليل العقليّ؛ هو الفطرة والقضايا الضروريّة التي لا تستطيع النفس دفعها إلا بالمعارض الباطل، وقد تقدّم كلام ابن تيميّة وابن حزم رحمهما الله في ذلك.
فالدليل العقليّ المتّفق عليه هو:
1) ما كان ضروريّاً لا يقبل النقض البتّة إلا بالهوى.
2) ما كان مضطرداً لأنّه أصل الخلقة في جميع الخلق الأسوياء.
وهذا العقل لا يمكن بحال أن يخالف الشرع ولا يعارضه بل دلّ الشرع عليه ونبّه إلى الاهتمام به والعناية به كما تقدّم والله أعلم.
الاستقراء:
يقسم إلى قسمين: كلّي وجزئيّ.
وأمّا الجزئيّ؛ فمختلف فيه ولا حديث لنا معه البتّة، وإنّما الحديث عن الاستقراء الكلّي الشامل لجميع الأفراد.
يقول ابن تيميّة رحمه الله: (وأمّا الاستقراء فإنّما يكون يقينيّاً إذا كان استقراءاً تامّاً وحينئذ تكون قد حكمت على القدر المشترك بما وجدّته في جميع الأفراد) [9].
وقال أيضاً: (والاستقراء هو الحكم على كلّي – نتيجته - بما تحقّق في جزئيّاته) [10].
وأمّا كونه فطريّ شرعيّ؛ فنعم.
قال ابن تيميّة رحمه الله عنه: (علم يقين لا يحتمل النقيض البتة، أمر معقول عمّا يشترك فيه ذوو العقول، قضاياه كلّية واجبة) [11].
وهذه كما تقدّم هي شروط الدليل العقلي الفطري الذي يصلح في إنشاء القضيّة المختلف عليها.
قاعدة في المصطلحات والألفاظ:
صياغة أيّ قاعدة تحتاج إلى أمرين:
1) دليل صدق موضوعها.
2) صواب بنيتها اللفظية في الدلالة على موضوعها ومعناها.
اعلم أخي المسلم:
أنّ الألفاظ خيول المعاني، وكما أمرنا الله تعالى بعدم اتّباع الظنّ والجهل والكذب كما قال تعالى: {ولا تقفُ ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً}، فكذلك أمرنا بإحسان الألفاظ وتخيّرها وانتقاء أحسنها للدلالة على الحقّ كما قال تعالى: {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن}، وقال تعالى {وقولوا للناس حسناً}.
وقد عقد أئمّتنا باباً في هذا الأمر وهو وجوب تخيّر الألفاظ الحسنة للمعاني الصائبة، وقد نهى الله تعالى عبيده عن بعض الألفاظ كما قال في كتابه: {يا أيّها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا}، وهذا كلّه لخطر الكلمة وأهمّيتها، ومعلوم أن الإبانة عن الشريعة بلغة العرب واجبة لمن قدر عليها، وإنّما سوّغ الأئمة الكلام بغير العربيّة للحاجة.
وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: (من تكلّم في مسجدنا بغير العربية أُخرج منه).
قال ابن تيميّة رحمه الله تعالى: (والذين يبدّلون اللسان العربي ويفسدونه هم من هذا الذمّ والعقاب بقدر ما يفتحونه، فإنّ صلاح العقل واللسان ممّا يؤمر به الإنسان، ويعين على ذلك تمام الإيمان، وضدّ ذلك يوجب الشقاق والضلال والخسران) [12].
والمصطلحات التي يحدثها الناس على قواعد العربيّة؛ منها ما هو مقبول، ومنها ما هو مردود، وقد اتّفق أهل العلم على أنّه لا يجوز إبدال الألفاظ الشرعيّة الدالّة على معاني شرعيّة وعدّوا هذا من الإلحاد والضلال، ودليل ذلك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتشار شرب الخمر في آخر الزمان، وتسميتها بغير اسمها.
ففي مسند الإمام أحمد بسند جيّد كما قال الحافظ ابن حجر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليشربنّ ناس من أمّتي الخمر يسمّونها بغير اسمها) [13].
لأنّ الألفاظ الشرعيّة قد تعلّقت بها أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن معرفة حكم الله تعالى إلا من خلال هذه الأسماء والمصطلحات، فإذا غيّرت هذه الأسماء كانت طريقاً إلى تغيير حكم الله تعالى وتبديله وهذا إلحاد وزندقة.
فهذه الأسماء - كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ والزنا والخمر والجهاد وأسماء الله تعالى وصفاته وأسماء الغيب كالجنّة والنار والجنّ والملائكة والإيمان - لا يجوز لأحد أن يضع لمعانيها أسماء أخرى، كما لا يجوز أن تستخدم لأيّ معنى لم يرده الشارع لها، لما قدّمنا من ارتباطها بأحكام الشرع، ولما تحدثه من أثر نفسيّ على سامعها قد استقرّ في قلبه.
فوقوع كلمة "الزنا" على النفس المسلمة لا يمكن أن يقوم بدلاً منه لفظ آخر مهما كان، فلو سمّاه الناس بـ "الجنس المحرّم" أو بـ "الحب المحرّم"، كما يطلق أهل الخبث في هذه الأيّام تهويناً لأمره ودفعاً عن مرتكبه شعور الخزي والندامة، فإنّه لن يترك في نفس سامعه الأثر الذي يحدثه لفظ الزنا في التنفير والتقبيح، وهذا أمر معلوم مشاهد.
وكذا لفظ "الخمر"، فلو استبدل بهذه الأسماء المحدثة الجديدة، وهي خبيثة بحقّ، مثل "المشروبات الروحيّة"، لما وجد الناس حرجاً في شربها وتداولها، وأمر اليهود في استحلال شحوم الحيوان بعد طبخها لتغيير الاسم أمر يعرفه أهل الإسلام، وكذا أفعال أهل الحيل وأفعال الصوفيّة في تسمية حب الله بالهوى والعشق، وتسمية الفلاسفة لخالق السموات والأرض بالعقل الفعّال، وغير ذلك من التبديل الباطل والضلال المبين.
وممّا جوّزه أهل العلم بلا خلاف وعلموا أنّ الشريعة لا تنهى عنه؛ هو إحداث أسماء للعلوم والآلات والفنون الحادثة، كتسمية علم أصول الفقه، وعلم النحو، وعلم العروض، وعلم التوحيد، فهذه هي وأمثالها ممّا قال فيه العلماء؛ لا مشاحة في الإصطلاح، ولا يُعاب محدثها بكونه ابتدع شيئاً جديداً لم يكن في عرف الأوائل إطلاقه، والعربية ما زال يتولّد منها الألفاظ والأسماء دون نكير من أحد من أهل العلم يعتدّ بقوله، ومنكر هذا جاهل مبطل لا يُلتَفَت له.
فالأسماء تُعرف من خلال قصد واضعيها، فما كان شرعيّاً يُعرف مراده من طريق الشرع، وما كان لغويّاً يُعرف اسمه من طريقها، وما كان عُرفيّاً يُعرف من طريق أهله.
قال ابن تيميّة: (الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يُعرف حدّه بالشرع، كالصلاة والزكاة، ونوع يُعرف حدّه باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حدّه بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: {وعاشروهنّ بالمعروف}) [14].
وهذا باب واسع جدّاً - أعني باب الأسماء والألفاظ والألقاب والمصطلحات - اقتصرت فيه على هذه النكتة فقط.
والله الموفّق.
التوحيد وأقسامه - نموذجاً -:
التوحيد ضدّ الشرك، وهو عبادة الله وحده، والشرك عبادة غير الله تعالى، والقرآن كلّه دعوة لتوحيد الله تعالى.
كما قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: (إنّ كلّ آية في القرآن متضمّنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإنّ القرآن إمّا دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يُعبَد من دونه؛ فهو التوحيد الإراديّ الطلبيّ... وإمّا خبر عن الله أسمائه وصفاته وأفعاله؛ فهو التوحيد العلمي الخبريّ).
فالتوحيد؛ إمّا أن تفعل لواحد وتطلب واحداً وتطيع واحداً وهو الله سبحانه وتعالى، وإمّا أن تقرّ وتصدّق أنّ الفعل والتصرّف والاسم والصفة هي لواحد.
فالأوّل يتعلّق بالإرادة والطلب، والثاني يتعلّق بالإثبات والمعرفة.
وهذا أمر مفطور في القلوب مسطور في الكتاب والسنّة، قال تعالى: {وما أُمروا إلاّ ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء}، وقال تعالى: {وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون}. وقال تعالى: {هل تعلم له سميّاً}، وقال تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها}، وقال تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحداً}، وقال تعالى: {إن الحكم إلاّ لله}... وغيرها من الآيات والأحاديث الدالّة على أنّ الله أمرنا أن لا نعبد إلا هو - الواحد - {قل هو الله أحد}، وأن نقرّ ونصدّق أنّ له أسماءً وصفاتاً وأفعالاً لم يشاركه فيها أحد - جلّت أسماؤه وصفاته وأفعاله -
وهذا هو الذي يسمّيه أهل الإسلام بالتوحيد.
وهذا التقسيم باعتبار أمرين:
الأوّل؛ باعتبار فاعله، فإنّ التوحيد الأوّل - الإراديّ الطلبيّ - يفعله المسلم لواحد – ربّه، الله - والتوحيد الثاني - العلميّ الخبريّ - هو فعل وأسماء وصفات الربّ نفسه.
الثاني؛ باعتبار آلة الإيمان في الإنسان، فمعلوم أنّ الإيمان قول وعمل، قول اللسان والقلب، وعمل الأركان والقلب، فالتوحيد الإرادي الطلبيّ هو عمل القلب والجوارح واللسان، وعمل القلب هنا الإرادة، والتوحيد العلميّ الخبريّ - الإثبات والمعرفة - متعلّق بالتصديق والإقرار وهو عمل القلب.
وهذا التقسيم مبناه على استقراء آيات الكتاب وأحاديث النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقد يقسّم التوحيد باعتبار آخر فيكون التوحيد يقسم إلى قسمين: توحيد الشرع وتوحيد القدر. وهذا التقسيم باعتبار ما يصدر من الواحد وهو الله سبحانه وتعالى لقوله سبحانه وتعالى {ألا له الخلق والأمر}، فالشرع لا يجوز أن يصدر إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو منه سبحانه "فعلاً" ولا يجوز أن يصدر من غيره "حكماً"، والقدر لا يكون إلا من خلقه ومشيئته "كوناً".
وقد قُسِّم التوحيد تقسيماً ثلاثيّاً، وليس له من سبب سوى الردّ على أهل البدع، وهذا التقسيم هو:
-
توحيد العبادة - ويسمّونها توحيد الإلهية أو الألوهيّة -
-
وتوحيد الربوبيّة.
-
وتوحيد الأسماء والصفات.
وتوحيد العبادة؛ هو عينه توحيد القصد والطلب، أو التوحيد الإرادي الطلبي، وتوحيد الربوبيّة؛ هو عينه توحيد الإثبات والمعرفة أو التوحيد العلمي الخبريّ، وتوحيد الأسماء والصفات؛ داخل في توحيد الربوبيّة، فإنّ أسماء الله وصفاته هي من ربوبيّته، وهي التي بها استحقّ إلهيّته على خلقه.
وهذا التقسيم - أي إفراد الأسماء والصفات بالذكر - سببه ما حصل من أهل البدع من نفي لأسماء الله وصفاته، إمّا نفي لمعناها مع إثبات ألفاظها، أو تأويل معناها مع إثبات ألفاظها، وإمّا نفي لمعناها ولفظها وذلك بعدم جواز نسبتها عندهم إلى الله تعالى - كما هو قول غلاة الجهميّة - ومنهم من جعلها مملوكة له كامتلاكه لكلّ خلقه، فجعلوا النسبة نسبة ملك كقولهم بيت الله، دابّة الله، فلمّا حدثت هذه البدع المبيرة أفردها العلماء بالذكر تنويهاً لشأنها وإبرازاً لها في مقابل أهل البدع.
دلّ هذا على أنّ ما هو حقّ لله وحده فهو من التوحيد ويجوز أن يُنسب له، فنقول؛ توحيد العبادة، ويجوز أن نقول؛ توحيد الشرع، ويجوز أن نقول؛ توحيد الطاعة، ويجوز أن نقول؛ توحيد النّسك، ويجوز أن نقول؛ توحيد الولاء والبراء، فإنّ هذه من حقّ الله على العبيد، ويجب عليهم أن لا يصرفوها إلا لله سبحانه وتعالى.
وأنَّ ما لا يفعله إلاّ الله؛ يجوز أن ينسب إلى التوحيد، كتوحيد القدر، وتوحيد الربّ الخالق المتصرّف الوهّاب وتوحيد الأسماء والصفات.
ولو نظر ناظرٌ إلى توحيد العبادة - الألوهيّة والإلهيّة - وأراد تقسيمه بحسب ما يصدر من الموحّد من أفعال فقسّمه بهذا الاعتبار فقال: إنّ الشرع وتألّه الإنسان به له ثلاثة اتّجاهات، فأفعال للإنسان جهة خالقه تسمّى بالنسك وأفعال للإنسان مع الناس باعتبار قسميهم المؤمن والكافر تسمّى الولاء والبراء، وأفعال جهة الأحكام والأفعال والأشياء والمعاني تسمّى التشريع والحكم فسمّاها بالحكم أو التشريع، لصحّ هذا وما كان مخطئاً.
فصار عنده توحيد العبادة يقسم إلى؛ توحيد النسك، وتوحيد الولاء والبراء، وتوحيد الحكم والتشريع.
ودليله هو عين دليل ما تقدّم من تقسيم أهل العلم، ومن نفاه فعليه أن ينفي التقاسيم السابقة.
وإنّه لمن الضروري كضرورة استنباط توحيد الأسماء والصفات من توحيد الربوبيّة وإفرادها بالذكر؛ أن نفرد توحيد الحكم والقضاء والتشريع بالذكر، لمّا صار من معارك كبرى حول حقّ الله على عبيده في الحكم والتشريع وإنكار أهل العصر له.
ألم يقل علماؤنا: (الإشراك بالله في حكمه كالإشراك بالله في عبادته) - كما قال الشنقيطيّ -؟
وألم يقل محمّد بن عبد الوهّاب في كتاب التوحيد: (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله فقد اتّخذهم أرباباً من دون الله)؟
فلماذا يكون هذا التوحيد بدعة؟ وهل البدعة هي الاجتهاد من نفس الغرز الذي اجتهد فيه السلف؟
إنّ قول هؤلاء المخالفين لتوحيد الحاكميّة ووسمه بالبدعة؛ قد رجموا بغير علم، وأفتوا بغير برهان، فلم ينصروا حقّاً ولم يبطلوا باطلاً، بل هم في حقيقة الأمر يسبغون على كفر التشريع وكفر الحكم وكفر القضاء؛ أثواباً من الباطل، ليستروهم بها.
والله الحافظ لدينه وقرآنه.
[1] مجموع الفتاوى: 9/158.
[2] مجموع الفتاوى: 13/137.
[3] درء تعارض العقل والنقل" 1/194.
[4] المرجع السابق: 1/198 - 200.
[5] ج2/ص 247، تحقيق عبدالواحد وافي.
[6] السابق.
[7] ص203.
[8] ص 204.
[9] الرد على المنطقيين ضمن مجموع الفتاوى: 7/188.
[10] السابق، 196.
[11] السابق: 127.
[12] مجموع الفتاوى: 32/255.
[13] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبّان في صحيحه.
[14] مجموع الفتاوى: 13/28.