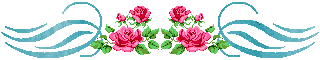المنافقون؛ بين العيان والخداع
المنافقون؛ بين العيان والخداع
للشيخ العلامة أبي قتادة الفلسطيني
 من أحسن الحديث
من أحسن الحديث
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
{ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام * وإذا تولّى سعى في الأرض ليفسدَ فيها ويهلكَ الحرث والنسل والله لا يحبّ الفساد * وإذا قيلَ له اتّقِ الله أخذته العزّة بالإثم فحسبه جهنّم ولبئس المهاد}.
ما الذي يأسر قارئ هذه الكلمات الإلهيّة؟! وما الذي يجعله يُشَدُّ إليها فيرجع إليها المرّة تلو المرّة، ويعيد النظر فيها ذهاباً وإياباً؟!
ألأنّها كلمات الربّ والتي هي صفة من صفاته؟ وهو القائل: {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله}.
أم لأنّها تكشف للمرء حقائق الباطن وتُصوّر ظواهره بأبلغ كلامٍ وأحسنه؟! والله يقول: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}.
أم لأنّها تُريك صوراً بشريّة كثيرة تنطبق عليهم تمام الانطباق فلا يخرمون منها شيئاً مهما قلّ أو صغر؟!
أم لأنّها تُسَلّيك في مواطن كثيرة تُغلب فيها بكلام الآخر في باطله وتعجز عن ردعه وغلبته في جولة المبارزة بالكلام، فتَجْبُر آلامك العظيمة فتطمئنّ أنّه؛ {حسبه جهنّم ولبئس المهاد}؟!
أم لأنّها تهدّئ روعك وجزعك أمام الظواهر الكاذبة مهما علت وتعاظمت، ومهما طال تغييبها الحق عن الناس؟! إنّها لذلك كلّه ولغير ذلك من أمور عظام.
يا إلهي ما أحسن حديثك وما أعظمه وما أحلاه وما أطلاه!
وقبل أن يتمثّل المسلم الصور البشرية المختزنة في هذه الآيات العظيمة فإنّه لا بدّ أن يَعْلَم ما في داخلها من معادلات، وكيف تعرض هذه الآيات فضائح المخبوء في هذه الصور القبيحة - صور المنافقين -
المعادلة؛ الشقّ الأول: الدعوى، الشقّ الثاني: الحقيقة.
الدعوى:
1) {يعجبك قوله في الحياة الدنيا}:
الإعجاب بالحديث يقع في النفس لسببين: البلاغة والموافقة؛ فالمرء يمدح القول ويتفاعل معه إذا رأى فيه قوّة الخطاب، فهي كالسحر - كما سمّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فالجمل البلاغيّة وصبّ المعاني في قوالبٍ من اللفظ الحسن تدعو السامع ولا بدّ إلى الإعجاب، والإعجاب هو مقدّمة قبول القول وقائله، لأنّ الإعجاب مبنيّ على الاستحسان، والاستحسان لا يقع إلاّ بعامل الرضا.
وههنا القرآن الكريم يكشف لنا عن مزلق من المزالق التي يقع فيها الكثير من الناس جهلاً، ويستخدمها دعاة الشرّ خبثاً، إنّه مزلق جمال الخطاب وقوّة البيان وحسن صياغة الأفكار، وهذا المزلق استُخدِم كثيراً في تاريخنا، كما يُستخدم اليوم كثيراً في واقعنا، فكم من داعٍ على أبواب جهنّم تمكّن بحسن بيانه وقوّة خطابه أن يأسر الناس إليه، ويسوق الجموع إلى فكره وعقيدته، فعلى العاقل الفطن أن لا ينساق إلى هذا المزلق، فلا تغرّه الظواهر التي تزيّن الباطل، بل عليه أن ينظر إلى حقيقة الموضوع وإلى المعاني الجوهريّة، فيدرس الأمور دراسة الوعي والعلم، لا دراسة الجمال والزينة.
ثمّ إذا نظرنا إلى الجانب الآخر من هذه المسألة لوجدنا كذلك أنّه من اللازم على دعاة الحقّ أن لا يغفلوا عن تقديم ما عندهم من حقّ وخير بأحلى عبارة وأجمل خطاب، إذ عليهم أن يتخيّروا العبارت والصور البيانيّة ما يكون داعياً للسامع أن يُقبِل على ما عندهم من هُدى، ولا نعني بهذا أن نجمّل الحقَّ بالشهوات، وأن نخلط الحقّ بالباطل، لأنّ الكثير من الناس يتمنّون أن يَعرضوا القرآن برغيف من "الساندويتش" أو أن يَلبس السنّة ثوب امرأة حسناء ليسارع الناس إليهما.
وليس هناك مثل القرآن أعظم في هذا الباب، فهو {أحسن الحديث}، ولهذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به "مثل الريحانة، ريحها طيّب وطعمها مرّ، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به مثل الأترجة، ريحها طيّب وطعمها طيّب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها"، وهذا يدلّ على أثر القرآن واتّخاذه وسيلة في الحجاج والحديث، ودوام الاستشهاد به، فإنّ الريح الطيّبة مدعاةٌ للقرب والقبول.
والقصد من هذا بيان؛ أنّ اللفظ الحسن لا يصحّ أن يتّخذ حاكماً على قضيّة من القضايا، كما أنّه كذلك لا ينبغي لأهل الحقّ أن يُعرضوا عنه لأثره على النفوس والقلوب.
وأمّا الشقّ الثاني الذي يقع بسببه الإعجاب؛ فهو الموافقة لما يقوله المتحدّث، والإعجاب ههنا بهذا الصنف من الناس يقع بسبب إظهاره موافقة أهل الحقّ لما عندهم، وإن كان هو في حقيقة الأمر يستخدم هذا لما يريده فيما بعد ذلك من المخاصمة وإثارة الشبهات وتزوير الحقّ الذي عند المؤمنين، لقوله سبحانه وتعالى: {وهو ألدّ الخصام}.
وهذا كلّه على اختيار أنّ قوله تعالى: {في الحياة الدنيا} متعلّقٌ بقوله سبحانه {يُعجبك}، أيّ أنّك تستحسن قوله ما دام في هذه الدنيا، لأنّه لا يصدر منه إلا القول الحسن، فهو يتكلّم بما يوافق ما عندكم من الحقّ والخير.
وقال بعض أهل العلم: إنّ قوله تعالى: {في الحياة الدنيا} متعلّق بقوله: {قوله}، أي أنّه يتقن الكلام فيما هو من شأن الدنيا.
والذي أراه - والله أعلم -؛ أنّ القول الأوّل هو الصواب، فإنّ إعجاب المؤمن بكلام المرء لا يكون إلاّ حين يتكلّم المرء بكلام الدين والحقّ، وأمّا كلام الدنيا فليس هو معيار الإعجاب عند المؤمن، ثمّ إنّ مراد الآيات هو بيان مخالفة كلام المرء بقوله الحسن مع فعله القبيح - وهو الإفساد في الأرض -
2) {ويشهد الله على ما في قلبه}:
إنّ أوّل ما يخطر على بالك عند هذه الكلمات أن تسأل: لماذا يُـسارع المجرم والمُبطِل - غالباً - إلى نقل الموضوع الذي يدور حوله الخلاف إلى المنطقة الخطأ؟ ولماذا يحاول المبطل - غالباً - التنبيه على ما يمكن أن يتّهم به لقرائن الحال؟!
فههنا رجل لو كَشَفَ الله تعالى عن قبله لرآه الناس من أقبح القلوب وأشنعها، ولأبصروا فيه أفاعي الشرّ وعقارب السوء، وهوام الحسد والحقد، وغيلان الزور والكذب، وهو مع ذلك يستهتر بربّه، وقد جعله من أهون الناظرين إليه، فالحديث معه يدور حول فعله القبيح - الإفساد في الأرض - فلماذا ينقله إلى أمر لا يمكن الاطلاع عليه على الحقيقة إلا من خلال هذا الظاهر، والقصد أنّ نقل الحوار والمناقشة إلى هذه المنطقة من الحديث هو نقل تعسُّفيّ يُراد منه إدخال الناس في الحوار الخطأ وصرف النظر عن القضيّة المهمّة، وهي: لماذا تُفسد في الأرض؟ فهي تحذير لنا أن لا نقبل من القول إلاّ ما احتفت به الأدلّة، وأن نحذر الحوار فيما لا يمكن البحث في حقيقته.
ولماذا يحلف بالله على صدق ما في قلبه وحسن نيّته؟! وهل ثمّة أحد سأله عن هذا؟
أهو تطبيقٌ للمثل القائل: يكاد المجرم أن يقول خذوني؟
أم هي قاعدة: لا بدّ للمجرم أن يعود إلى مكان جريمته؟
أم هو هاجس الكذب وقلقه على النفس، فيبقيه شاعراً بمعرفة كلّ الناس له مع استحضار عاقبة الخيبة والخسران؟
إنّ هذه الآيات بمقدار ما تفضح الأيمان الكاذبة، بمقدار ما تنفّرك وتقزّزك من هذا السمت والنمط، فهي تبيّن أن جريمته الأولى ليست خصومتهم مع المسلمين، وإنّما هي جريمة أخرى تسبق ذلك، إنّها جريمةٌ تقع منهم تجاه ربّهم وخالقهم، فانظر إلى استهتارهم بنظر الله إليهم، وبهوان مراقبة الله لقلوبهم، فهم يحلفون بالله ويشهدونه عما في قلوبهم دون خجل أو حياء، أفمثل هؤلاء الذين لا يُقيمون رأساً لنظر الله إليهم يمكن أن يطمع المرء العاقل أن يقيموا رأساًلنظر الناس إليهم؟!
والآية لا تبيّن لنا ماذا يشهد هذا المنافقُ ربَه على ما قلبه، بل تركها الربّ لنا مفتوحة لأنّ هذا الترك هو قمّة الامتلاء، فإنّ هناك العديد والآلاف من الصور التي يمكن للمرء أن يملأها من واقعه، فهي دعوة لنا أن نملأها بالصور التي نراها وتعيش بيننا.
فإذاً هو: {يعجبك قوله في الحياة الدنيا} [+] {ويشهد الله على ما في قلبه}.
هذا هو شقّ المعادلة الأوّل.
لكن ما هي حقيقة هذا المدّعي؟ وأيّ صنفٍ من الناس هو؟ هذا ما أراد القرآن بيانه.
وممّا يستوقفك هنا؛ أنّ هذه المقدّمة تجعلك تسير سيراً حسناً مع الموصوف وكأنّك في راحةٍ من حاله ووضعه، فقوله حسن تَعْجب له، وأيمانه مُغلَّظة أنّه صادقٌ محسن، ولكن ما يأتي يجابهك بصدمة تعادل صدمتك بما تراه من واقع الموصوف، وهي صفة لازمة لهذا القرآن العزيز أنّ مراد الربّ في كلامه معروض مع حركة الكلام الإلهي.
فههنا مقدّمة تريحك وتبعث في نفسك الراحة والاطمئنان، ولكنّها تريحك لتكون الصدمة القادمة والعاصفة الآتية أكثر تأثيراً على نفسك.
فكان بعد ذلك أن قال: {وهو ألدّ الخصام}، وكلمة "ألدّ" تقطع النَفَس الذي انساب قبل قليل مرتاحاً مع قوله سبحانه وتعالى: {ومن الناس...}، فهي كلمات تتأنّى في قراءتها وكأنّك تسير مع سهل منبسط تحت قدميك، ولكن للحظة مفاجئة تأتي الهزّة: {وهو ألدّ..}، إنّها نفس الحالة الواقعية في تعامل المسلم الموحّد مع هذا الصنف من البشر.
فتذكّر هذا مع كلّ آيات الكتاب تراه جليّاً واضحاً.
وتذكّرها فيما يأتي من قوله سبحانه {ولبئس المهاد}، فكلمة المهاد تبعث على الراحة والهناء، ولكن ما قبلها يرفع هذا المعنى إلى ضدّه؛ {ولبئس}، فكأنّك مع فراش وثير في ظاهره ولكن حقيقته الشقاء والتعب، إنّه نفس الخداع الحاصل من حـال هؤلاء المنافقين - الظاهر شيءٌ والباطن شيءٌ آخر -
فتذكّر هذا مع القرآن ولا تنساه.
إنّه؛ {وهو ألدّ الخصام}، هذه أوّل علامة من العلامات الدالّة على قبح صورته الحقيقية من غير تزوير وتخييل، عوج المجادلة فلا يستقيم على حقّ في خصومة، و "اللدّ" في اللغة؛ شدّة الخصومة وعوجها، فهو لا يخضع لحقّ ولا يقبل دليلاً ولو أتيته بملء الأرض حججاً.
إنّ مقابلة هذا الصنف من البشر هي أسوء ما يمكن للمرء أن يلقاه في حياته، ولكنّ صورها في الواقع كثيرة وكثيرة جدّاً، إنّ من صور هذه الكلمات في واقعنا وفي حياة البشر: كلّ من حاجج بباطل، وكلّ من استخدم الكذب في حواره، وكلّ من تعالى عن قبول الدليل الحقّ، أو أخرج أي بحثٍ عن موضوعه من أجل التمويه والغلبة، وكلّ من آنف أن يعترف للآخر بالحقّ والصواب.
وفي هذه الكلمات الربّانية تسلية للمؤمن ولصاحب الحقّ؛ أنّه وإن فاتته الغلبة على خصمه المجادل لتصرّفه بالكلام المعسول، أو لتركيبه مقدّمات متناقضة للوصول إلى أهدافه، فإنّه وإن ضاع حقّه في الدنيا فلن يضيع عند الله تعالى.
وفيها الردّ على من ظنّ أن نهاية أي حوار بين حقّ وباطل، بين سنّة وبدعة، بين صواب وخطأ، ينبغي أن ينقطع الباطل في جداله وسكوت صاحبه، لا، إنّ هذا القول خطأ ولا شكّ، فإنّ من قاس ميزان الصواب والخطأ بهذا المقياس سيجني على نفسه الشرّ ولا شكّ، ولكن لنتذكّر أنّ للحقّ نوراً وعلامات.
ذكر الذهبي في السير [11/249] في كلامه عن المحنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: قال صالح بن الإمام أحمد عن أبيه: (فإذا جاء شيء من الكلام مما ليس في الكتاب والسنّة، قلت: ما أدري ما هذا).
والقرآن الكريم علّمنا أن نعرض عن المجادل المعاند، واقرأ إن شئت قوله تعالى: {لا حجّة بيننا وبينكم}، فإنّها جليّة واضحة في أنّ حججنا عند المعاندين لا تُقبَل لعدم اهتدائهم بها، ولأنّهم لا يُقيمون لما نحتجّ به رأساً، فإنّهم لا يعتبرون أنّ الكتاب والسنّة يقطعان حجج المناظر، كما أنّ أدلّتهم من الباطل لا نقيم لها شاناً، فليس هناك من أرضيّة مشتركة للحوار بين الموحّد وبين المعاند.
وهذا إن تفكّر المرء به في هذا الزمان؛ رأى أن الكثير من الزاعمين لفتح الحوار بين الأديان أو بين المذاهب للتقريب بينها فيما يزعمون إنّما يضطرون إلى مسايرة أهل الباطل في الكثير من مبادئهم وذلك بِكَتْم بعض ما أنزل الله تعالى أو بتأويل بعض معانيه ظانّين أنّ عداء اليهود والنصارى لدين الله تعالى إنّما هو لعدم فهمهم للدين، ولذلك راحوا يشرحون الإسلام بصورة - زعموا أنّها الحق - بها يرضى اليهود والنصارى عن الإسلام، وهي في الحقيقة صورة تشوّه الإسلام ولا تحسّنه.
ولذلك صدق من قال: إنّ الله لما علم أنّ في الناس من لا ينفعه الكتاب الذي أنزله الله، أنزل معه الحديد فيه بأس شديد لعلمه أنّه لا يُخرج المراءَ من أدمغة أهل اللجاج إلا الحديد.
وإلاّ فماذا يصنع المسلم مع من يقول: {ربّنا عجّل لنا قطّنا} - أي عذابنا -؟ إنّ الجواب هو؛ قوله تعالى: {إصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنّه أوّاب}.
إنّ هؤلاء القوم: {ولئن جئتهم بآية ليقولنّ الذين كفروا إن أنتم إلاّ مبطلون}، {فإنّك لا تُسمع الموتى ولا تسمعُ الصمَّ الدعاءَ إذا ولّوا مدبرين، وما أنتَ بهادِ العمي عن ضلالاتهم إن تُسمِع إلاّ من يؤمنُ بآياتنا فهم مسلمون}، فالفصل بين الناس ليس في هذه الدنيا، إنّما هو ليوم الفصل، يوم القيامة، ومن ظنّ أنّه يمكن الفصل بين كلّ المختلفين في هذه الدنيا فهو مضيّع لوقته في غير ما فائدة.
ولذلك كان الواجب على المسلم أن يبيّن الحقّ كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل، وبالطريقة النبوية التي عرض بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وكلّ زعْمٍ أنّ هناك طريقة أسلم أو أعلم من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو زعمٌ ضالٌّ مبطل.
الحقيقة:
1) {وإذا تولّى سعى في الأرض ليفسدَ فيها ويُهلِكَ الحرثَ والنّسلَ والله لا يحبُّ الفساد}:
فهذه هي الحقيقة التي تكذّب كلّ الدعاوى اللفظيّة، وهي التي ينبغي أن يُحكَم على المرء من خلالها، فإنّ آلاف المحسّنات اللفظيّة لا يمكن أن تقفَ أمام حقيقةٍ واقعيّة، وإنّ الأيمان المغلّظة المزعومة لا يمكن أن تثبُتَ أمام حجج الواقع العيانيّة.
إنّها تكشف استخفاء هؤلاء القوم، فهم أمام المؤمنين يتكلّمون الكلام الحسن، ويبشّون في الوجوه، ويحلفون إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً، فإذا طلب منهم العمل المؤيّد لما يقولون لم يأتِ منهم إلا الشرّ، فإذا خرجوا من عندك - {إذا تولّى} - ملأ الدنيا شروراً وفساداً؛ {سعى في الأرض} والسعي هو المشي السريع.
إنّها كلمات تملأ النفس بصورِ حكّام الردّة والكفر، فانظر - بالله عليك - إلى مطابقة الخبر الربّاني لمخبَر هؤلاء المجرمين.
فحسبنا الله ونعم الوكيل، كم خدعوا من جاهل وكم لبّسوا على الناس.
وههنا نقطة مهمّة جليلة؛ وهي الخلاف حول ميزان القبح والحسن، ميزان الخير والشرّ، ذلك لأنّ هؤلاء المجرمين من لددهم الباطل وجدالهم الفاسد ما كشفه الله تعالى بقوله: {وإذا قيلَ لهم لا تُفسدوا في الأرض قالوا إنّما نحن مصلحون ألا إنّهم هم المفسدونَ ولكن لا يشعرون}، فهم يسّمون إفسادهم إحساناً.
ألم يسمّوا الزنا والدعارة حرّيةً وفنّاً؟!
ألم يسمّوا الخمر مشروبات روحيّة؟!
ألم يسمّوا الزندقة حرّية فكريّة؟!
ألم يسمّوا بيع البلاد والعباد سلماً وإخاءً؟!
وهكذا تحوّل الفساد في الأرض إلى خير وجمال، وصار معيار الشيطان في الحقّ والخير هو المعيار والميزان.
ولكنّ قوله سبحانه وتعالى: {والله لا يحبّ الفساد}، يقطعُ عليهم أهواءهم، فإنّه سبحانه وتعالى ما نهى عن أمرٍ إلا وفيه مفسدة، وما أمر بأمر إلا وفيه مصلحة، فهو سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، ولا معقّب لحكمه.
2) {وإذا قيل له اتّق الله أخذته العزّة بالإثم فحسبه جهنّم ولبئس المهاد}:
وههنا دليلٌ آخر على كذب دعواه، وأنّه لا يُقيم لربّ العزّة شأناً، وأنّ أمر الله تعالى عنده هيّن لا قيمة له.
فإنّه إذا نُوصِحَ أعرضَ وتولّى، بل {أخذته العزّة بالإثم}، وانظر إلى هذا الكلام الربّاني: {أخذته}، فكأنّها تنقله نقلة بعيدة، إنّها نقلةٌ إلى الشرّ، وما الحامل له على ذلك؟ {العزّة بالإثم}.
إنّه يتعامل مع حقائق باطنيّة ثابتة لديه؛ الإثم، فهو قرينه ووليّه، وهو مقياسه وميزانه، يغضب له وينتصر له ويتحاكم إليه، وهو مفتخر به، يتعالى بصحبته، والمرء المسلم يعتزّ بالحقّ وبانتسابه إليه، ولكنّ هذا؛ عزّته بالإثم، فانتصاره له يحكم مواقفه، ومحبّته له تسيّر خطواته، فإذا كان الخيار بين؛ {إتّق الله}، وبين؛ {العزّة بالإثم}، كان المقدّم عنده: {العزّة بالإثم}.
وههنا نكتة لا بدّ من ذكرها وهي تكشف الحقائق المخفيّة؛ رجلٌ في حال السعة والرخاء وترتيب المواضيع على مهل وتؤدة؛ يُعجبك قوله، فهو محضر نفسه للعرض أمام المؤمنين، ألبَسَ نفسه القناع، ولكنّه في هيجانه الشيطاني وخلال سعيه الدؤوب للإفساد في الأرض، لو فاجأه موحّد بقوله: "إتّق الله" تفجّرت حينئذ الحقائق وكشف عن مخبوء نفسه وفجأة: {أخذته العزّة بالإثم}.
ولم تبيّن لنا الآية ماذا فعل حين {أخذته العزّة بالإثم}، لأنّ الترك ههنا - كما هو في كلّ موضع - من أبلغ الإملاء والإحاطة.
{فحسبه جهنّم ولبئس المهاد}:
وههنا سأتكلّم عمّا شعرت به في نفسي حين وقفت وكلّما وقفت على هذه الخاتمة: إنّه شعور الرضا، شعور الأمان بأنّ الله لن يترك هؤلاء على آمالهم الكاذبة، وشعور الثقة أنّ الله هو الحقّ المبين، وأنّه سينتصر للضعفاء وسيذلّ المستكبرين، ثمّ هي تبيّن عاقبة هذا المكر السيّئ وهذا النفاق القبيح، ما الذي سيجنيه؟ أيظنّ أنّه يخدع ربّ العالمين، وسيأخذ الدنيا والآخرة؟ لا والله! بل {حسبه جهنّم ولبئس المهاد}.
والحمد لله ربّ العالمين